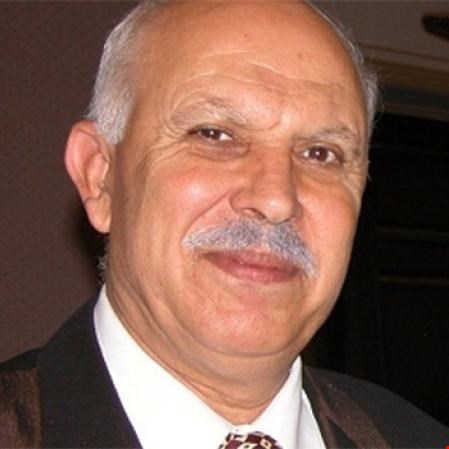قضايا وآراء » قضايا وآراء مختارة من الصحف اللبنانية الصادرة الجمعة 10/12/2010

- 'السفير'
خريطة الطريق القانونية لوقف نفاذ أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان درءاً للفتنة
عدنان عضوم:
إذا كانت الحكومة اللبنانية الفاقدة للشرعية والميثاقية آنذاك قد خالفت الأصول القانونية والدستورية، وطلب رئيسها فؤاد السنيورة من الأمين العام للأمم المتحدة الإستعجال بإنشاء المحكمة مع علمه بعدم اكتمال الشروط القانونية، فإن القرار 1757/2007 الصادر بموجب الفصل السابع والذي تعتريه العيوب السابق ذكرها، لا يغطي هذه المخالفات ولا يجعل الشروط القانونية الواجب اكتمالها لبدء نفاذ الاتفاق محققة، وتكون أعمال المحكمة الخاصة بلبنان غير نافذة لمخالفتها الاتفاق الثنائي لإنشاء هذه المحكمة وأحكام الدستور، ويجب تعليقها لحين إتمام الإجراءات الدستورية اللازمة المشار إليها أعلاه.
بناءً عليه، من حق وواجب مجلس الوزراء اللبناني، وهو السلطة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق الدولي، اتخاذ القرار المناسب للطلب من مجلس الأمن تعليق نفاذ القرار 1757/2007، وبالتالي تعليق نفاذ الاتفاق الثنائي وعمل المحكمة الخاصة بلبنان، وذلك لحين إنجاز التعديلات الدستورية، وسنّ القوانين الوطنية التي تتلاءم مع أحكام الاتفاق، وتوقيع وإبرام الاتفاق وفقاً للأصول الدستورية المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور اللبناني، وذلك لحسن سير العدالة وانتظام الحياة القانونية والدستورية، ولكون هذه الإجراءات الضرورية تستلزم فترة من الزمن لإنجازها.
كما أنه من حق وواجب رئيس الجمهورية اللبنانية، باعتباره مؤتمناً على احترام الدستور وتقع عليه التبعة في حال خرقه، الطلب من مجلس الوزراء اتخاذ القرار المشار إليه أعلاه والقيام بالاتصالات اللازمة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بهذا الخصوص، لتحقيق هذا الأمر.
III- وجوب تعليق نفاذ القرار 1757/2007 لمنع الوصاية الدولية الدائمة على القضاء اللبناني
ألف - توسيع اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان خلافاً للقرار 1664/2006 ولميثاق الأمم المتحدة وللقوانين والأعراف الدولية والدستور اللبناني
بموجب القرار 1664/2006، وافق مجلس الأمن الدولي وبناءً لطلب الحكومة اللبنانية على إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المسؤولين عن الجريمة الإرهابية التي حصلت في 14/2/2005، وأدَّت إلى وفاة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، على أن يتم إنشاؤها بموجب اتفاق ثنائي بين الأمم المتحدة ولبنان. ويتبيَّن بالتالي أن اختصاص هذه المحكمة محصور فقط بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، إلا أن الاتفاق الثنائي الذي وافقت عليه الحكومة الفاقدة للشرعية آنذاك بالانفراد، ووضع موضع التنفيذ في القرار 1757/2007 تحت الفصل السابع، وسَّع نطاق اختصاص هذه المحكمة ليشمل الهجمات التي حصلت بين 1/10/2004 و 12/12/2005 وأكثر من ذلك أيضاً، الهجمات التي حصلت أو قد تحصل مستقبلاً في أي وقت لاحق لتاريخ 12/12/2005 يقرره الطرفان ويوافق عليه مجلس الأمن، إذا رأت هذه المحكمة أن هذه الهجمات مرتبطة ببعضها، وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية، وذات طابع وخطورة يماثلان طابع وخطورة الهجوم الذي وقع في 14/2/2005، ويشمل هذا الارتباط مجموعة عوامل على سبيل المثال لا الحصر: القصد الجنائي، طبيعة الضحايا المستهدفين ونمط الهجمات.
إن توسيع هذا الاختصاص يجعل المحكمة الخاصة مفتوحة الصلاحية تتجاوز ولايتها حدود الولاية القضائية التي وضعها مجلس الأمن في قراره 1664/2006، ولا يستند إلى أي أساس قانوني صحيح ويخالف مضمون هذا القرار مخالفة صارخة ويشكل تنازلاً عن الصلاحية القضائية اللبنانية، وعن السيادة الوطنية ويضع القضاء اللبناني تحت الوصاية الدولية لفترة زمنية غير محددة. وإن توسيع هذا الاختصاص من قبل الفريق القضائي اللبناني وفريق الأمم المتحدة المفاوض، وخارج إطار قرار مجلس الأمن 1664/2006 غير قانوني ومثير للريبة ويطرح أسئلة عديدة عن السـبب الحقيقي لهذا التوسيع.
كما أن توسيع الاختصاص القضائي للمحكمة على الشكل المشار إليه في الاتفاق الثنائي، يخالف الغاية من إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومبادئ العدالة الجنائية الدولية. وهذه الغاية هي إيجاد محكمة استثنائية للنظر في جرائم محدَّدة ارتكبت قبل إنشائها وخلال مدة معينة (محكمة يوغوسلافيا سابقاً، المحكمة المختلطة لمحاكمة الخمير الحمر في كمبوديا)، وليس للنظر في جرائم غير محدَّدة أو مرتقبة قد تحصل مستقبلاً، كما هي الحالة في المحكمة الخاصة بلبنان وإن هذا التوسيع في الاختصاص غير جائز قانوناً ويخالف القوانين والأعراف الدولية بهذا الشأن، كما أنه يشكل انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما الفقرة السابعة من المادة الثانية التي تنص على وجوب احترام السيادة الوطنية للدول الأطراف، والمادة العشرون من الدستور اللبناني التي تولي للقضاء اللبناني وحده ممارسة السلطة القضائية على الأراضي اللبنانية.
باء - اعتماد قاعدة مسؤولية القادة والرؤساء الجنائية عن أفعال مرؤوسيهم مخالف لمبادئ العدالة الجنائية الدولية وقانون العقوبات اللبناني الواجب مراعاتها في الاتفاق الثنائي للمحكمة
إن مسؤولية الرئيس الجنائية عن الأفعال الجرمية التي يرتكبها مرؤوسوه والتي اعتمدت في الاتفاق الثنائي لإنشاء المحكمة هي مسؤولية مفترضة &laqascii117o;Pr&eacascii117te;sascii117m&eacascii117te;e" لا تحتاج إلى إثبات وهي ناتجة عن إهمال أو قلة احتراز في ممارسة الرئيس سيطرته على مرؤوسيه وليست مسؤولية شخصية ناتجة عن اشتراك أو تدخل في الجريمة ارتكبه الرئيس. إن هذه المسؤولية المفترضة سبق أن اعتمدت في بعض المحاكم الجنائية الدولية، لأن الجرائم التي كانت تنظر فيها هذه المحاكم، هي جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية. وكان سبب ذلك طبيعة هذه الجرائم، فهي جرائم شاملة ومتمادية تحصل في إطار حروب وهجمات مسلحة بين جماعات وجيوش متقاتلة، بقيادة، أو تنفيذاً لأمر، أو بعلم وتغاضي قادتهم العسكريين، وحتى لا يتملَّص أي شخص من مسؤولية المشاركة أو الفشل في منع أعمال الإبادة والتعديات الجماعية. وإن هذه الجرائم تختلف بطبيعتها وعناصرها عن الجريمة الإرهابية الفردية التي استهدفت الرئيس الحريري والتي هي من اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان، كما جرى توصيفها من قبل مجلس الأمن والاتفاق الثنائي، وليست بالتالي جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب أو إبادة. ومن جهة ثانية، إن هذه المسؤولية المفترضة، أي مسؤولية الرئيس عن أفعال مرؤوسيه غير منصوص عليها في الاتفاقية الثنائية التي اعتمدت فقط بعض المواد من قانون العقوبات اللبناني المفروض تطبيقها من قبل المحكمة الخاصة بلبنان، ولا في المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدولة اللبنانية وأصبحت بقوة القانون الوطني.
لذلك وعملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وقاعدة عدم رجعية النصوص القانونية الجنائية الموضوعية، لا يجوز اعتماد قاعدة مسؤولية الرئيس عن أفعال مرؤوسيه الجرمية المشار إليها أعلاه وغير المنصوص عليها في القوانين اللبنانية عند حصول الجريمة والمستحدثة بموجب الاتفاق الثنائي لإنشاء المحكمة الخاصة لتطبيقها على جريمة اغتيال الرئيس الحريري المرتكبة قبل بدء نفاذ هذا الاتفاق.
ورداً على السؤال الذي يُطرح عن سبب اعتماد قاعدة مسؤولية الرئيس الجنائية عن أفعال مرؤوسيه في الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان والتي لا علاقة لها بالجرائم ضد الإنسانية، يمكن الجواب بأن نية واضعي الاتفاق الثنائي من فريق الأمم المتحدة والفريق اللبناني، هي استعمال المحكمة الخاصة، كأداة ضغط وتهديد ضد رؤساء أحزاب أو زعماء سياسيين لبنانيين، والنيل منهم، لتحميلهم المسؤولية عن الجريمة المذكورة وليس لإحقاق الحق والوصول إلى العدالة.
وما يؤكد ذلك أن بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية تضمنت معلومات عن إمكانية توجيه الاتهام فقط إلى عناصر أو أفراد في مجموعات حزبية لبنانية، وعسكريين تابعين لدول إقليمية، للتخفيف من وقع القرار الاتهامي على الرأي العام اللبناني في حال صدوره، إلا أن هذا الأمر يخفي في طيّاته مناورة هدفها الوصول في مرحلة لاحقة إلى اتهام كبار المسؤولين الحزبيين وإلى قادة هذه الدول، كما حصل سابقاً في محاكم يوغوسلافيا ورواندا وكمبوديا. وهذا ما يعرف بالطريقة المتدحرجة في تقنية المحاكم الدولية، إذ أنه من الممكن كما هو مبيَّن في قواعد الإجراءات والإثبات العائدة للمحكمة الخاصة بلبنان، أن يوجّه المدعي العام اتهاماً على دفعات، كما حصل سابقاً في محكمة يوغوسلافيا.
وهذا هو السبب الرئيسي الذي حمل واضعي اتفاقية المحكمة على وضع قاعدة مسؤولية الرئيس عن مرؤوسيه التي لا تطبق إلا على الجرائم ضد الإنسانية، كما سبق ذكره رغم معرفتهم بالواقع القانوني لهذه القواعد، وعدم إمكانية تطبيقها لا من قريب أو من بعيد على الجريمة الإرهابية الفردية التي أودت بحياة الرئيس الحريري. وهذا الأمر يفرض على الحكومة اللبنانية منعاً ودرءاً للفتنة أن تطلب من الأمم المتحدة تعليق العمل بهذه المواد استناداً للمادة العشرين من اتفاقية المحكمة، وإعادة النظر بها تمهيداً لتصحيح المسار القانوني لهذه المحكمة بالنسبة للقواعد المذكورة إنسجاماً مع مبادئ ومعايير العدالة الجنائية الدولية.
جيم: عدم احترام قوة القضية المحكوم بها للأحكام الصادرة عن القضاء اللبناني من قبل المحكمة الخاصة بلبنان
أجازت المادة الخامسة فقرة (2) من نظام المحكمة الخاصة، محاكمة أي شخص سبق أن تمت محاكمته أمام محكمة لبنانية، وصدر بحقه حكم عن أي فعل جرمي داخل اختصاص المحكمة في حال كان هذا الحكم قضى ببراءته وحتى في حال قضى بتجريمه وإنزال عقوبة بحقه، وذلك اذا قدرت المحكمة الخاصة، ان القضاء اللبناني الذي حاكمه يفتقر الى اعتبارات الحياد، أو أن الادّعاء اللبناني لم يكن قد أدَى دوره بالعناية الواجبة! وهنا يقتضي التأكيد أن الحكم القضائي اللبناني عندما يصبح نهائياً ويكون له قوة القضية المحكمة يرتب حقوقاً مكتسبة لمن صدر الحكم بوجهه، ولا يجوز لأي جهة المساس بهذه الحقوق بآثار رجعية إلا بموجب نص قانوني، كما أن عدم احترام قوة القضية المحكمة للأحكام الصادرة عن القضاء اللبناني وباسم الشعب اللبناني، يخالف المادة العشرين في الدستور اللبناني الذي يولي للمحاكم اللبنانية لوحدها حق اصدار الأحكام باستقلالية تامة، وبالتالي فإن التعرض للأحكام القضائية يخالف الدستور ويمسّ بالسيادة الوطنية، الأمر الذي يستوجب تعديل الدستور وفقاً للأصول القانونية لاعتماد امكانية محاكمة الجرم مرتين المشار اليها في المادة الخامسة فقرة (2) المذكورة أعلاه.
كما انه من ناحية ثانية، ان المادة 181 من قانون العقوبات اللبناني، تمنع ملاحقة الجرم الواحد الا مرة واحدة، وهذه القاعدة تعتمدها معظم الأنظمة القانونية لا سيما الفرنسي والبريطاني والأميركي.
ويقتضي الملاحظة أن الأحكام الواردة في المادة الخامسة فقرة (2) هي أحكام استثنائية سبق أن اعتمدت في نظام المحاكم الجنائية الدولية المحضة (يوغوسلافيا سابقاً وراوندا)، ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تمارس اختصاصها على جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، باعتبار ان هذه الجرائم شديدة الخطورة وتثير قلق المجتمع الدولي بأسره ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من العقاب.
أما بالنسبة للأفعال الجرمية التي هي من اختصاص المحكمة الخاصة، فإنها جرائم فردية إرهابية وليست بجرائم حرب او إبادة أو جرائم ضد الإنسانية، كما أنه لم يصدر أي قرار اتهامي عن القضاء اللبناني في أي من هذه القضايا، وللمحكمة الخاصة سلطة الإطلاع على التحقيقات والإجراءات القضائية التي يقوم بها القضاء اللبناني في هذه الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة الخاصة، والطلب إذا شاءت من هذا القضاء التنازل عن اختصاصه لمصلحتها سنداً للمادة الرابعة من نظام المحكمة.
لذلك يكون إيراد هذه الأحكام في نظام المحكمة الخاصة عديم الجدوى، وهناك خوف من أن يكون الهدف من اعتماد هذا المبدأ، هو توسيع اختصاص هذه المحكمة لتشمل جرائم سبق أن صدرت فيها أحكام قضائية مبرمة عن السلطة القضائية اللبنانية، لا تناسب بعض المراجع الدولية، ويراد إجراء الملاحقة بها مجدداً عن طريق التذرع بأن هذه القضايا لم تنظر بإتقان من قبل القضاء اللبناني ولم تكن إجراءات المحاكمة الوطنية محايدة أو مستقلة.
IV- وجوب استئخار النظر في دعوى جريمة اغتيال الرئيس الحريري ووقف أعمالها لحين تحديد المرجع القضائي الصالح للنظر في دعوى جرائم شهادة الزور والافتراء والبت بالدعوى المتعلقة بهذه الجرائم
نصت المادة الرابعة فقرة أولى من نظام المحكمة الخاصة بلبنان أن للمحكمة الخاصة وللمحاكم الوطنية في لبنان إختصاصاً مشتركاً، وتكون للمحكمة الخاصة ضمن اختصاصها اسبقية على المحاكم الوطنية.
ونصت المادة الثالثة من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي ترعى أعمال المحكمة أن تفسير هذه القواعد يتم وفقاً لروحية نظام المحكمة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي ولقانون الإجراءات الجزائية الدولي واللبناني.
ألف ـ تلازم جرائم شهادة الزور والافتراء المشتبه ارتكابها لدى لجنة التحقيق الدولية والقاضي العدلي اللبناني مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري
- بتاريخ 29/4/2009، صدر قرار قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان السيد فرانسين المستنِد إلى طلب المدعي العام الدولي القاضي بيلمار في قضية اغتيال الرئيس الحريري، فوافق على الإفراج عن الضباط الأربعة المحتجزين من قبل القضاء اللبناني منذ 30/8/2005 استناداً إلى توصية رئيس لجنة التحقيق الدولية السيد ميليس، وتضمن هذا القرار ما خلاصته أن إفادات الأشخاص التي تم توقيف الضباط على إثرها غير صادقة وإن المعلومات الموجودة في ملف التحقيق حول التورط المحتمل لهؤلاء الضباط في الهجوم على الرئيس الحريري غير موثوق بها كفاية لتبرير إيداع قرار اتهام بحق أي متهم.
- يتبيَّن أن هذا القرار يشير إلى أن بعض الأشخاص ارتكبوا إحدى الجرائم التالية: الإدلاء بشهادة الزور للتعمية عن الحقيقة أو الافتراء عن طريق إعطاء معلومات كاذبة ونسبتها إلى أشخاص محدّدين يعرفون براءتهم منها. وتعتبر هذه الجرائم التي ارتكبت لإخفاء نتائج جريمة اغتيال الرئيس الحريري أو لإبقاء منفذيها من دون ملاحقة، جرائم متلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري سنداً للمادة 133 من قانون أصول المحاكمات اللبناني لوجود رابطة معينة تجمع بينها من دون أن تؤدي إلى امتزاجها بحيث تبقى كل منها جريمة مستقلة. إلا أنه يقتضي بموجب القانون المذكور إحالتها معاً إلى مرجع جزائي واحد، وإن يكن غير صالح بالنسبة إلى بعضها وغاية ذلك تأمـين حسن سير العدالة.
باء ـ تنازل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن اختصاصها للنظر في جرائم شهادة الزور والافتراء
إن العناصر القانونية للجرائم المتلازمة متوافرة بين جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وهذه الجرائم المرتكبة لتضليل التحقيق ولإبقاء منفذي جريمة إغتيال الرئيس الحريري ورفاقه من دون ملاحقة لوجود رابطة وثيقة تجمع بينها، مما يستوجب إيلاء المحكمة الدولية الخاصة صلاحية النظر بجرم شهادة الزور لحسن سير العدالة. وما يعزِّز هذا الرأي أن نظام المحكمة الدولية يعطيها الأسبقية لاختصاصها على اختصاص المحاكم اللبنانية، وإن للمدعي العام الدولي، استناداً لنظام المحكمة الدولية، الصلاحية الواسعة للتحقيق مع كل الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الخاصة. وقد كرست القواعد الإجرائية المطبقة من قبل المحكمة الصلاحية الشاملة للمدعي العام الدولي لتولّي أي تحقيق له علاقة بقضية اغتيال الرئيس الحريري وفقاً للأصول القانونية الواجبة التطبيق.
إلا أن المفارقة، أن المدعي العام الدولي، بدلاً من أن يجري التحقيقات والملاحقات في جرائم شهادة الزور والافتراء التي هي من اختصاص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وفقاً لما تقدم ذكره، عمد مكتبه إلى إصدار عدة تصريحات أيّدها هو بنفسه، أنه غير معني وغير مختصّ للتحقيق والملاحقة في جريمة شهادة الزور، أو المعلومات الكاذبة التي أُدلي بها أمام القضاء اللبناني، أو لجنة التحقيق الدولية، وقت كان القانون اللبناني المتعلق بالإجراءات والملاحقة هو المطبَّق على كل الأعمال التي كانت تجريها لجنة التحقيق الدولية التي كان يرأسها مؤخراً قبل أن يصبح مدعياً عاماً للمحكمة، ومتذرعاً بأن أحكام ملاحقة جريمة شهادة الزور المعني بها هي فقط المنصوص عليها في المادة 152 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وتتناول فقط شهادة الزور بعد حلف اليمين المدلى بها أمام إحدى غرف هذه المحكمة الدولية.
إن موقف المدعي العام الدولي المذكور يفيد أن المحكمة الدولية لا تريد ممارسة اختصاصها في ملاحقة هذه الجرائم المتفرعة والمتلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري كما بيًّنا أعلاه، ويُصبح بالتالي القضاء اللبناني حكماً صاحب الاختصاص لملاحقة هذه الجرائم سنداً لأحكام المادة الرابعة من نظام المحكمة المشار إليها أعلاه، ولقانون العقوبات اللبناني، لا سيما المادة الخامسة عشرة منه، التي تولي صلاحية المحاكم اللبنانية النظر في هذه الجرائم باعتبار أنها ارتكبت في الأراضي اللبنانية وفقاً لأحكام هذه المادة التي تنص على أنه تعد الجريمة مقترفة في الأراضي اللبنانية إذا تم على هذه الأراضي أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو فعل من أفعال جريمة غير مجتزأ، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي، كما إذا حصلت النتيجة في الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيها.
جيم- المرجع القضائي اللبناني المختص للنظر في جرائم شهادة الزور والافتراء
بسبب الخلاف الذي نشأ حول أصول إحالة ملف شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس الحريري إلى القضاء اللبناني والمرجع القضائي المختص للنظر فيه، كلف مؤخراً مجلس الوزراء وزير العدل إبراهيم نجار درس الملف وتقديم تقرير حول هذا الموضوع. ورأى واضع التقرير أن ملاحقة جريمة شهود الزور هي من اختصاص القضاء العادي وليس من صلاحية المجلس العدلي. ولتاريخه لم يتخذ مجلس الوزراء قراراً في هذا الموضوع لوجود خلافات حادة بين فريقين في الحكومة، مع الإشارة إلى أن مجلس الوزراء له حصرياً الحق بإحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي إذا إرتأى ذلك، وسنداً للمادة 355 أصول محاكمات جزائية، من دون أن يكون له الاختصاص بإحالتها إلى أي مرجع قضائي عادي، عملاً بمبدأ فصل السلطات. وتوضيحاً لهذا الموضوع، نبدي ما يلي:
إن جريمة اغتيال الرئيس الحريري أحيلت إلى المجلس العدلي بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء آنذاك، وتضمن هذا القرار إحالة جريمة اغتيال الرئيس الحريري وكل ما يتفرع عنها إلى المجلس العدلي. ويكون هذا المجلس بالتالي المرجع القضائي المختص للنظر بجرائم شهادة الزور والافتراء كونها متلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري وفقاً للمادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما ذكرنا سابقاً. وأنه لحسن سير العدالة، وحتى لا يبقى الفاعلون الحقيقيون لجريمة نالت من رئيس وزراء لبنان من دون ملاحقة تؤدي إلى توقيف الفاعل الأساسي، فإنه يقتضي إيلاء هذه القضية المتفرعة عن القضية الأصلية إلى قاضي التحقيق العدلي كون التحقيقات والمستندات والأدلة لا تزال موجودة في دائرته، ولأنه المرجع الأصلح والأفضل لتولّي النظر في هذه الجرائم. لذلك يقتضي على المحقق العدلي الذي كان واضعاً يده على ملف اغتيال الرئيس الحريري أن يباشر تحقيقاته في هذه الجرائم.
دال ـ وجوب استئخار البت في دعوى جريمة اغتيال الرئيس الحريري لحين البت بدعوى جرائم شهادة الزور والافتراء بعد وضع القضاء اللبناني يده عليها
تطبيقاً للمادة الرابعة من نظام المحكمة المذكورة أعلاه وللمبادئ الجنائية العامة ولقواعد الإجراءات الجزائية الدولية واللبنانية التي ترعى عمل المحكمة الخاصة بلبنان، يوجد تواصل وتعاون قضائي مستمر بين هذه المحكمة، والمحاكم الوطنية الواضعة يدها على الدعاوى التي تدخل في الاختصاص المشترك، بحيث أنه على المحاكم الوطنية إطلاع المحكمة الدولية على التحقيقات التي تجريها في الدعاوى ذات الاختصاص المشترك.
وفي إطار هذا التعاون يتوجب على قاضي التحقيق العدلي أو أي مرجع قضائي عادي ينظر في ملف جرائم شهادة الزور والافتراء في قضية اغتيال الرئيس الحريري إطلاع المحكمة الخاصة على هذه التحقيقات التي يجريها، كون هذه الجرائم متلازمة ومتفرعة عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وتدخل في الاختصاص المشترك، وقد تؤثر على نتيجة الدعوى الأصلية، كما أنه على المرجع القضائي المذكور الطلب من المحكمة الدولية وفقاً للأصول المعتمدة للتخاطب استئخار السير بدعوى جريمة اغتيال الرئيس الحريري، لحين البت في دعوى جرائم شهادة الزور والافتراء المتلازمة معها، والتي أدَّت إلى تضليل التحقيق، وحجبت الحقيقة عن هوية الفاعل الحقيقي، عن أنظار فريق التحقيق الدولي والادّعاء العام والمحكمة بكافة هيئاتها، والمساهمين معه في ارتكاب هذه الجريمة النكراء، وأخلَّت بسير العمل القضائي، وعطَّلت إمكانية توصله إلى معطيات وحقائق تقود إلى جلاء الحقيقة ومعرفة الفاعل لسوقه إلى العدالة.
ونرى أنه على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستجابة لطلب القضاء اللبناني ووقف أعمالها وتقرير استئخار النظر بدعوى اغتيال الرئيس الحريري، لحين البتّ بدعاوى جرائم شهادة الزور والافتراء المتلازمة مع الدعوى الأصلية، لما قد تؤثر نتيجتها على هذه الدعوى ولحسن سير العدالة وتطبيقاً لقاعدة اختصاص هذه المحكمة المشترك مع القضاء اللبناني المعتمد في نظام المحكمة وقواعدها الإجرائية.
وفي الختام،
وبعد أن ظهر للجميع أن القرار 1757/2007 لم يحترم بنود ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وبعد أن ظهر عدم احترامه لاستقلال لبنان وسيادته بإقراره الإتفاقية الثنائية للمحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع للسماح للحكومة اللبنانية الفاقدة للشرعية واللاميثاقية آنذاك، بإجراء الاتفاقية من دون اتباع الإجراءات الدستورية اللازمة لإبرام الاتفاقيات الدولية وفقاً للدستور اللبناني كي تصبح هذه الاتفاقية نافذة، وبالتالي أجرى مجلس الأمن اتفاقاً مع نفسه وحلّ مكان الدولة اللبنانية في هذا الأمر وأنشأ محكمة هجينة لا تصنيف لها في نوعية المحاكم الدولية السابقة بحيث لا يُعرف ما إذا كانت محكمة ذات طابع دولي أو محكمة دولية محضة، ولا تُعرف القواعد القانونية الواجب تطبيقها عليها، أو الأحكام اللازم إخضاعها لها، وبحيث لا يمكن تحديد القاعدة الواجب مراعاتها لتكوين هذه المحكمة، وتعيين قضاتها، وكيفية عملها، وآلية تمويلها، والقانون الصائب الواجب تطبيقه.
لذا فإن اتباع هذه الطريقة يتيح المجال للبنان ودرءاً للفتنة عن نسيج مجتمعه، أن يصار إلى إعادة النظر في مقومات هذه المحكمة وقرار وضعها موضع التنفيذ، وأن تبادر الحكومة اللبنانية وسنداً للمادة العشرين من اتفاقية المحكمة مخاطبة الأمم المتحدة طالبة منها تصويب الخطأ الذي اعترى إنشاء هذه المحكمة، وإعادة النظر بتكوينها بأن يكون قضاتها بمجملهم دوليين إذا اعتُبرَت محكمة دولية محضة، أو مختلطين إذا اعتُبرَت ذات طابع دولي، وأن تَسحب قضاتها من هذه المحكمة إذا اعتُبرَت محكمة دولية صرفة طالما أنها وضعت تحت الفصل السابع، وأن يصار إلى تمويلها من قبل الأمم المتحدة باعتبارها هيئة فرعية للأمم المتحدة وفقاً لنص المادة التاسعة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة، وخاضعة لسلطة مجلس الأمن. وقد صدقت المقولة السائدة &laqascii117o; رُبَّ ضارَّة نافعة".
- 'النهار'
شمال الغجر لبناني مشمول بالخط الأزرق وسكّانه سوريون ومزارع شبعا تستدعي وثائق وترسيماً لشرعنة لبنانيتها
تحقيق: إبراهيم حيدر:
عادت قضية قرية الغجر المحتلة الى الواجهة، بعدما قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر في 17 تشرين الثاني سحب قواته من الجزء الشمالي للقرية، من دون أن يحدد موعداً للانسحاب، مشترطاً ان تكون المنطقة في عهدة اليونيفيل، إضافة الى اعتراف دولي بتطبيقه القرار الدولي الرقم 1701.
لكن القرار الاسرائيلي بالانسحاب من الجزء الشمالي لقرية الغجر لا يعيده الى السيادة اللبنانية، بفعل الشروط الاسرائيلية، كما ان هذا الانسحاب لا يكتمل من دون خروج الجيش الاسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والتي حضرت بقوة منذ العام 2000، تاريخ الانسحاب من الشريط المحتل.
واذا كانت قضيتا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وضعتا على الرف منذ العام 2006، فإن قضية قرية الغجر المحتلة، بقيت حاضرة بفعل موقعها الجغرافي، وكونها تتداخل بالأراضي اللبنانية، باعتبار ان الغجر المحتلة هي سورية في الأساس وتقع في الطرف الشمالي الشرقي لهضبة الجولان المحتلة، حيث توسعت لتشمل أراضي لبنانية سيطرت عليها اسرائيل.
في ملف الغجر، رفض لبنان في العام 2009 اقتراحاً يقضي بوضع الشق اللبناني المحتل من القرية في عهدة القوات الدولية (يونيفيل) بعد انسحاب اسرائيل منها، مصراً على وضعها تحت السيادة اللبنانية من خلال انتشار الجيش اللبناني فيها، ودعّم لبنان موقفه بوثائق ترسيم الخط الأزرق ما بين لبنان واسرائيل والتي تشير الى ان قسماً من قرية الغجر لبناني وينبغي استرداده. وتبقى هذه القضية عالقة، وتشكل مصدر توتر مستمر على الحدود طالما بقيت محتلة، وهي المنطقة الوحيدة التي لا تزال محتلة مع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتشكل خرقا واضحاً وعلنياً للقرار 1701.
قرية الغجر
احتلت إسرائيل قرية الغجر مع احتلالها هضبة الجولان السورية المتاخمة في العام 1967، ولم تكن القرية ممتدة في اتجاه الشمال اللبناني. وبموجب الخط الأزرق للحدود اللبنانية أصبح شمال الغجر جزءاً من لبنان، مما ترك الجزء الجنوبي تحت سيطرة إسرائيل.
وأخلت إسرائيل شمال الغجر في العام 2000 عندما أنهت احتلالها لجنوب لبنان الذي استمر 22 عاماً، لكن لبنان لم يستعد سيادته الا على تخوم القرية، قبل ان تعاود احتلالها مرة أخرى خلال حرب تموز العام 2006، ولم تنسحب منها.
وحتى حزيران 1967 كانت القرية تخضع للإدارة السورية، وإن كانت مشكلتها أكثر تعقيداً منذ تحديد الحدود اللبنانية – الفلسطينية - السورية في العام 1923، وفي اتفاق الهدنة العام 1949، إذ تارة كانت تعتبر لبنانية وتارة أخرى سورية وثالثة مشتركة، الى ان حسمت سوريتها نهاية خمسينات القرن الماضي. ويقال انه عندما احتلت إسرائيل منطقة الجولان من سوريا في العام 1967، لم تدخل اولاً الى قرية الغجر لاعتبارها لبنانية، رغم ان لبنان لم يكن يمارس سيادته عليها.
وحين احتلت اسرائيل المنطقة الحدودية من لبنان في العام 1978، توسعت الغجر شمالا داخل الأراضي اللبنانية. ومنحت اسرائيل سكان الغجر الجنسية الاسرائيلية في عام 1981، بعدما قرر الكنيست الاسرائيلي من خلال 'قانون الجولان' ضّم الجولان الى دولة اسرائيل.
وبعدما انسحبت اسرائيل من الجنوب في 2000، شمل الخط الأزرق الجزء الشمالي من الغجر، فاضطرت اسرائيل الى إخلائه من دون ان يدخله الجيش اللبناني الذي لم يكن قد انتشر بعد في الجنوب، ولذلك فإن الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر، لا يرتبط فقط بالقرار 1701، انما يتعلق بالقرار 425 أيضاً والانسحاب يعيد الوضع الى ما كان عليه قبل العام 2006، وهي المنطقة الوحيدة التي لم ينسحب منها بعد عدوان تموز، أما انسحابه فلا يحل المشكلة نهائياً لأن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال تحت الاحتلال.
مزارع شبعا وتلال كفرشوبا
كانت مزارع شبعا حتى 25 أيار العام 2000، غائبة عن القاموس اللبناني المقاوم في نسخاته المتنوعة ولا تندرج في مفرداته، فالتركيز كان منصباً على منطقة الشريط الحدودي المحتل منذ 1978، والذي توسعت حدوده بعد العام 1982، اذ كان القرار الدولي الرقم 425 يلحظ حدود الخط الممتد من الناقورة وصولاً الى تلال كفرشوبا في العرقوب بمساحة تقارب الألف كيلومتر مربع.
ولأن مزارع شبعا لبنانية تاريخياً، كما يؤكد تاريخ المنطقة وروايات أهالي العرقوب ومرتفعات جبل الشيخ، لم يكن يتذكرها سوى اللبنانيين المعنيين مباشرة بها، بفعل علاقتهم بأرضها والمساحات المثمرة من الأراضي التي يملكونها فيها بحجج غير مسجلة رسمياً في الدوائر العقارية اللبنانية. فأراضي هذه المنطقة غير ممسوحة من الدوائر العقارية اللبنانية، وهو ما شكل ثغرة في الخرائط الرسمية الموجودة بحوزة لبنان، والنسخ المختلفة الموجودة في دوائر الأمم المتحدة المختصة وبعض الدول الكبرى، وخصوصاً في الخارجية الفرنسية.
بدأت قضية مزارع شبعا تظهر الى العلن وتبرز بقوة الى الواجهة بعد تحرير المنطقة المحتلة من الجنوب وتحديد الخط الأزرق طبقاً لوثائق اتفاق هدنة 1949. فتركز نشاط المقاومة في منطقة المزارع وتلال كفرشوبا، تحت عنوان ان هذه الأراضي لبنانية وينبغي تحريرها من الاحتلال الاسرائيلي، وان القرار 425 لم يكتمل تطبيقه طالما ان مزارع شبعا محتلة، وهو ما يعطي مشروعية لاستمرار المقاومة. وتناغمت الدولة اللبنانية والحكومات المتعاقبة منذ العام 2000 حتى عام 2005 مع هذا التوجه.
وفي معزل عن النقاش الدائم حول وظيفة المقاومة ودورها، وبصرف النظر عن أحقية طرح الأسئلة حول المنطقة، وحسابات الجدوى والمصالح الوطنية اللبنانية، خصوصاً بعد حرب تموز وصدور القرار 1701، فإن الأمر يستدعي التوقف فعلاً أمام خصوصية مزارع شبعا، في ضوء التأكيد اللبناني على استمرار العمل بمختلف الوسائل لتحرير ما تبقى من أراض محتلة في الجنوب اللبناني.
احتلال المزارع
احتل معظم مزارع شبعا في العام 1967، عندما كانت المنطقة خاضعة للسيطرة السورية بموافقة لبنانية. وقد وضعت سوريا مخافر في المزارع بطلب لبناني بعد عام 1958 لمنع التهريب، علماً أنها كانت تقر بلبنانيتها. ودفع احتلال الجولان السوري المحاذي للمزارع بالأمم المتحدة الى الحسم في ادراجها تحت القرار 242، من دون بروز اي موقف لبناني يسمح بإبقاء منطقة المزارع في الخارطة اللبنانية، اذ كانت هناك خشية من ان تضع أي مطالبة بذلك لبنان أمام متطلبات الصراع العربي – الاسرائيلي وانعكاساته. ولكن بعد العام 2000 اعتبرت الحكومة اللبنانية ان المزارع مشمولة بالقرار 425، من دون أن تعطي الوجه القانوني لذلك، ما أدى الى تعارض حقيقي وحاد بين النظرتين.
ومنذ تحرير القسم الأكبر من الجنوب اللبناني، أو معظم الشريط الحدودي باستثناء مزارع شبعا وبعض تلال كفرشوبا، لم يقدم لبنان، ولا يملك، لسوء الحظ، حتى الآن العدة اللازمة والوثائق القانونية الرافعة لتغيير نظرة الأمم المتحدة، واستطراداً المجتمع الدولي من قضية المزارع، بصرف النظر عن النقاش في مشروعية المقاومة، وهو أمر لم يكن بارزاً عند التدقيق في خط الانسحاب الاسرائيلي على طول الحدود الجنوبية، اذ يملك لبنان الاثباتات الضرورية والخرائط في شأن خط &laqascii117o;بوليه – نيوكامب" العام 1923، وخط الهدنة للعام 1949، ما مكنه من استعادة ملايين الأمتار المربعة عند وضع الخط الأزرق عام 2000، رغم تحفظه عن عدد من النقاط الحدودية.
واذا كانت قضية الحدود المرتبطة بالخط الأزرق تبقي ملف الحدود مفتوحاً، فهناك أراض لبنانية لا تزال وراءه، وبينها أراضٍ في قاطع كفرشوبا، كما إن للحديث عن مزارع شبعا معنى مختلفاً، ففي حين أنه لا يوجد خلاف داخلي حول لبنانية المزارع، وان هذا الخلاف يظهر في الشق المتعلق بالخيارات المتاحة، وما اذا كانت تحظى بإجماع اللبنانيين بعد انجاز التحرير، ومعها حسابات الكلفة والفاعلية في اطار ما تبقى من الصراع مع اسرائيل على المستوى العربي، فإن استكمال الملف اللبناني حول المزارع تجاه المجتمع الدولي، وربما تجاه الداخل اللبناني، يعيد نسب المزارع الى القضية الوطنية اللبنانية، علماً ان عدوان تموز، لم تكن مزارع شبعا شرارته الرئيسة.
ويحق للبنان تأكيد لبنانية مزارع شبعا، كما يحق له اعتبار القرار 425 الذي صدر في آذار العام 1978 نص على الانسحاب الاسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، ويحق له أن ينظر الى أي قطعة أرض محتلة مهما صغرت مساحتها من منطلق سيادي، لكن منطقة المزارع، التي لها وضع خاص منذ العام 1967 ، والتطورات التي حصلت فيها، تفرض على لبنان اعادة النظر في طريقة تعاطيه مع هذه المسألة نحو تصويب الخلل القانوني المرتبط بملفها.
واذا كان اللبنانيون يشاهدون من وقت الى آخر دوريات قوات 'اندوف' الدولية تجوب منطقة المزارع اللبنانية امتداداً من الجولان السوري المحتل، كونهما تابعين لمسؤوليتها انطلاقاً من القرار 242، فإن ذلك لم يكن مستغرباً على المستويين الدولي والاقليمي، لأن قوة 'اندوف' التي ترابط على الخط الفاصل بين القوات السورية والقوات الاسرائيلية في الجولان تقوم بمهمتها الطبيعية، انطلاقاً من ان اتفاق فصل القوات الموقع العام 1974 بعد حرب الاستنزاف السورية في الجولان، لحظت حدودها منطقة المزارع، باستثناء مزرعة بسطرة، وهي آخر مزرعة احتلتها اسرائيل العام 1972.
على هذا، فإن احتلال مزارع شبعا حصل العام 1967، بدءاً بمزرعة 'المغر' التي تتداخل بين الحدود اللبنانية والفلسطينية والسورية، والتي تفصل منطقة المزارع عن وادي العسل السوري، وهي المزرعة الأولى التي احتلت في 10 حزيران 1967، ثم استولت اسرائيل في 15 حزيران على مزارع 'خلة غزالة' و'ظهر البيادر' و'رويسة القرن' و'جورة العقارب' و'فشكول' وهجرت معظم سكانها. وفي 20 حزيران من العام 1967، استكملت اسرائيل اجتياحها لمزارع 'قفوه' و'زبدين' و'بيت البراق' و'الربعة' و'برختا التحتا' و'برختا الفوقا' و'كفردورة' و'مراح الملالي'. وفي آب من العام نفسه احتلت مزرعة 'رمثا' وهجرت كل سكان المزارع وفجرت منازلهم. واكتمل احتلال المزارع العام 1972 باجتياح مزرعة بسطرة، فضمت مساحاتها المتبقية وسيّجت المنطقة بأسلاك شائكة ومكهربة.
موقف لبنان
لم يحدث احتلال مزارع شبعا ردود فعل رسمية لبنانية طوال تلك المدة، ولم تظهر في وثائق الأمم المتحدة أي شكوى رسمية لبنانية بين عامي 1967 و1974، رغم صدور قرارات للمنظمة الدولية تطالب اسرائيل باحترام أراضي لبنان وسيادته وتدعوها الى الانسحاب من أراض كانت اجتاحتها على طول الحدود الدولية من الناقورة الى كفرشوبا في ستينات وسبعينات القرن الماضي، أما الاشارة الوحيدة التي ظهرت رسمياً فهي من خلال عدد من النواب خلال مناقشات البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة في لبنان بين العامين 1968 و1974، والتي اقتصرت على المطالبة بإثارة موضوع احتلال اسرائيل للمزارع ومساعدة مهجريها والمهجرين من منطقتي القنيطرة والحولا في الجولان المحتل وشمال فلسطين الذين لجأوا الى بلدة شبعا، ومطالبة مجلس الجنوب آنذاك بالتعويض عن الأهالي الذين لم يكن قانون التعويض يلحظ ممتلكاتهم في المزارع، بعكس أهالي منطقة كفرشوبا وكفرحمام وراشيا والهبارية وشبعا.
مشكلة وثائق
وفي الواقع، لم يتوقف احتلال اسرائيل للمناطق المتاخمة للمزارع في تلك الحقبة في العرقوب على المزارع وحدها، بل امتد الى غير منطقة، خصوصاً في قاطع كفرشوبا، ولا تزال حتى الآن تحتل أجزاء منه، خصوصاً جبل الروس الذي يعرف بـ'رويسة العلم'، وهو عبارة عن تلة دارت معارك طاحنة حولها بين الفلسطينيين والاسرائيليين العام 1970، و'رويسة السماقة' و'مشهد الطير' وخراجات أخرى تمتد من كفرشوبا في اتجاه القنيطرة السورية. ويملك لبنان خرائط مفصلة لهذه الأراضي التي وردت في خرائط الحدود للعام 1943، باستثناء مزارع شبعا.
على ان هناك نقطة أخرى تتمسك بها الأمم المتحدة وتملك وثائق كافية حولها، وهي أن خط انتشار قوات الطوارئ الدولية 'اليونيفيل' الحالية في المنطقة الجبلية، المحاذية للمزارع وعلى الخط الأزرق، هو الخط نفسه الذي اتفق عليه العام 1978 بين لبنان والمنظمة الدولية، وهو الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تتمسك به وتصرّ عليه عند وضع الخط الأزرق بعد التحرير، من دون أن تفضي الاعتراضات اللبنانية والمتحفظة الى نتيجة ملموسة.
انطلاقاً من ذلك، تكون اسرائيل بدأت باحتلال المزارع العام 1967، واقتطعتها في شكل تام العام 1972، بعدما سوّرتها وأحكمت السيطرة عليها بطرد جميع من فيها، ثم عادت وثبتت قرار الضمّ مع صدور قرار عن القيادة الاسرائيلية العام 1989، رغم أن اسرائيل كانت لا تزال تحتل الشريط الحدودي بكامله حتى منطقة جزين، والقرار يلحق المزارع بقيادة الجولان وجبل الشيخ. ولم تنفع في رد ذلك تحركات وزارة الخارجية اللبنانية، التي أرسلت تعليماتها الى مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة بضرورة اجراء اتصالات لتأمين ضغط دولي من أجل وقف الضم الذي حصل منذ العام 1967 وأوجد واقعاً مختلفاً على الأرض عن واقع مناطق الشريط الحدودي الأخرى.
لم ينفِ احتلال اسرائيل لمزارع شبعا وضمها واندراجها في اتفاق فصل القوات العام 1972 بين سورية واسرائيل، لبنانية المزارع بالنسبة الى اللبنانيين عموماً، خصوصاً الجنوبيين منهم. والمعمرون الذين لا يزالون على قيد الحياة يروون ان سورية طلبت من لبنان منتصف الخمسينات من القرن الماضي العمل على وقف التهريب من هذه المنطقة الجبلية في اتجاه فلسطين المحتلة، عبر مثلث مغرسبكا اللبنانية – بانياس السورية - الحولة الفلسطينية. ولما لم تكن للبنان قدرة على ذلك، وضعت سورية مخافر أمنية في المنطقة بموافقة لبنانية، في حين اقتصر التدخل اللبناني على دوريات للجمارك اللبنانية كانت تحصي أعداد الماشية وتدقق في ما اذا كانت حصلت عمليات تهريب أم لا. ولذلك حين اجتاحت اسرائيل المنطقة لم تكن توجد في المزارع سوى قوات سورية، فنسبت الأمم المتحدة المزارع المحتلة الى القرار 242.
حاول لبنان التحرك من أجل اثبات لبنانية مزارع شبعا، وقدم خرائط محلية تثبت ملكية اللبنانيين لأراضي المزارع، مع حجج ملكية لعدد من اللبنانيين. وتبين أن الأمم المتحدة تملك خرائط عدة لا تشير الى لبنانية المزارع وتنسبها الى سورية ملحقة اياها بالجولان السوري المحتل. لكن تاريخ المنطقة يؤكد لبنانية المزارع التي كان يعيش فيها لبنانيون، وهي لا تتعدى بمجملها مساحة 40 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يفترض تحركاً لبنانياً على غير مستوى واتفاقاً مع سورية يعيد تثبيت لبنانية المزارع بوثيقة ترفع الى الأمم المتحدة تعترف بلبنانية المزارع وتعطي الأمم المتحدة دفعاً لاعادة النظر في خرائطها واعادة ترسيم حدود المنطقة. وربما يستدعي ذلك طلباً من الأمم المتحدة لاستصدار قرار يساهم في اخراج اسرائيل من المنطقة، ومن خلال قضية الغجر يمكن شرعنة المطالبة اللبنانية باستعادة المزارع، بما يتجاوز الكلام الانشائي المتبادل حول لبنانيتها.
خريطة الطريق القانونية لوقف نفاذ أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان درءاً للفتنة
عدنان عضوم:
إذا كانت الحكومة اللبنانية الفاقدة للشرعية والميثاقية آنذاك قد خالفت الأصول القانونية والدستورية، وطلب رئيسها فؤاد السنيورة من الأمين العام للأمم المتحدة الإستعجال بإنشاء المحكمة مع علمه بعدم اكتمال الشروط القانونية، فإن القرار 1757/2007 الصادر بموجب الفصل السابع والذي تعتريه العيوب السابق ذكرها، لا يغطي هذه المخالفات ولا يجعل الشروط القانونية الواجب اكتمالها لبدء نفاذ الاتفاق محققة، وتكون أعمال المحكمة الخاصة بلبنان غير نافذة لمخالفتها الاتفاق الثنائي لإنشاء هذه المحكمة وأحكام الدستور، ويجب تعليقها لحين إتمام الإجراءات الدستورية اللازمة المشار إليها أعلاه.
بناءً عليه، من حق وواجب مجلس الوزراء اللبناني، وهو السلطة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ هذا الاتفاق الدولي، اتخاذ القرار المناسب للطلب من مجلس الأمن تعليق نفاذ القرار 1757/2007، وبالتالي تعليق نفاذ الاتفاق الثنائي وعمل المحكمة الخاصة بلبنان، وذلك لحين إنجاز التعديلات الدستورية، وسنّ القوانين الوطنية التي تتلاءم مع أحكام الاتفاق، وتوقيع وإبرام الاتفاق وفقاً للأصول الدستورية المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور اللبناني، وذلك لحسن سير العدالة وانتظام الحياة القانونية والدستورية، ولكون هذه الإجراءات الضرورية تستلزم فترة من الزمن لإنجازها.
كما أنه من حق وواجب رئيس الجمهورية اللبنانية، باعتباره مؤتمناً على احترام الدستور وتقع عليه التبعة في حال خرقه، الطلب من مجلس الوزراء اتخاذ القرار المشار إليه أعلاه والقيام بالاتصالات اللازمة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بهذا الخصوص، لتحقيق هذا الأمر.
III- وجوب تعليق نفاذ القرار 1757/2007 لمنع الوصاية الدولية الدائمة على القضاء اللبناني
ألف - توسيع اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان خلافاً للقرار 1664/2006 ولميثاق الأمم المتحدة وللقوانين والأعراف الدولية والدستور اللبناني
بموجب القرار 1664/2006، وافق مجلس الأمن الدولي وبناءً لطلب الحكومة اللبنانية على إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المسؤولين عن الجريمة الإرهابية التي حصلت في 14/2/2005، وأدَّت إلى وفاة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، على أن يتم إنشاؤها بموجب اتفاق ثنائي بين الأمم المتحدة ولبنان. ويتبيَّن بالتالي أن اختصاص هذه المحكمة محصور فقط بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، إلا أن الاتفاق الثنائي الذي وافقت عليه الحكومة الفاقدة للشرعية آنذاك بالانفراد، ووضع موضع التنفيذ في القرار 1757/2007 تحت الفصل السابع، وسَّع نطاق اختصاص هذه المحكمة ليشمل الهجمات التي حصلت بين 1/10/2004 و 12/12/2005 وأكثر من ذلك أيضاً، الهجمات التي حصلت أو قد تحصل مستقبلاً في أي وقت لاحق لتاريخ 12/12/2005 يقرره الطرفان ويوافق عليه مجلس الأمن، إذا رأت هذه المحكمة أن هذه الهجمات مرتبطة ببعضها، وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية، وذات طابع وخطورة يماثلان طابع وخطورة الهجوم الذي وقع في 14/2/2005، ويشمل هذا الارتباط مجموعة عوامل على سبيل المثال لا الحصر: القصد الجنائي، طبيعة الضحايا المستهدفين ونمط الهجمات.
إن توسيع هذا الاختصاص يجعل المحكمة الخاصة مفتوحة الصلاحية تتجاوز ولايتها حدود الولاية القضائية التي وضعها مجلس الأمن في قراره 1664/2006، ولا يستند إلى أي أساس قانوني صحيح ويخالف مضمون هذا القرار مخالفة صارخة ويشكل تنازلاً عن الصلاحية القضائية اللبنانية، وعن السيادة الوطنية ويضع القضاء اللبناني تحت الوصاية الدولية لفترة زمنية غير محددة. وإن توسيع هذا الاختصاص من قبل الفريق القضائي اللبناني وفريق الأمم المتحدة المفاوض، وخارج إطار قرار مجلس الأمن 1664/2006 غير قانوني ومثير للريبة ويطرح أسئلة عديدة عن السـبب الحقيقي لهذا التوسيع.
كما أن توسيع الاختصاص القضائي للمحكمة على الشكل المشار إليه في الاتفاق الثنائي، يخالف الغاية من إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة، وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومبادئ العدالة الجنائية الدولية. وهذه الغاية هي إيجاد محكمة استثنائية للنظر في جرائم محدَّدة ارتكبت قبل إنشائها وخلال مدة معينة (محكمة يوغوسلافيا سابقاً، المحكمة المختلطة لمحاكمة الخمير الحمر في كمبوديا)، وليس للنظر في جرائم غير محدَّدة أو مرتقبة قد تحصل مستقبلاً، كما هي الحالة في المحكمة الخاصة بلبنان وإن هذا التوسيع في الاختصاص غير جائز قانوناً ويخالف القوانين والأعراف الدولية بهذا الشأن، كما أنه يشكل انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا سيما الفقرة السابعة من المادة الثانية التي تنص على وجوب احترام السيادة الوطنية للدول الأطراف، والمادة العشرون من الدستور اللبناني التي تولي للقضاء اللبناني وحده ممارسة السلطة القضائية على الأراضي اللبنانية.
باء - اعتماد قاعدة مسؤولية القادة والرؤساء الجنائية عن أفعال مرؤوسيهم مخالف لمبادئ العدالة الجنائية الدولية وقانون العقوبات اللبناني الواجب مراعاتها في الاتفاق الثنائي للمحكمة
إن مسؤولية الرئيس الجنائية عن الأفعال الجرمية التي يرتكبها مرؤوسوه والتي اعتمدت في الاتفاق الثنائي لإنشاء المحكمة هي مسؤولية مفترضة &laqascii117o;Pr&eacascii117te;sascii117m&eacascii117te;e" لا تحتاج إلى إثبات وهي ناتجة عن إهمال أو قلة احتراز في ممارسة الرئيس سيطرته على مرؤوسيه وليست مسؤولية شخصية ناتجة عن اشتراك أو تدخل في الجريمة ارتكبه الرئيس. إن هذه المسؤولية المفترضة سبق أن اعتمدت في بعض المحاكم الجنائية الدولية، لأن الجرائم التي كانت تنظر فيها هذه المحاكم، هي جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية. وكان سبب ذلك طبيعة هذه الجرائم، فهي جرائم شاملة ومتمادية تحصل في إطار حروب وهجمات مسلحة بين جماعات وجيوش متقاتلة، بقيادة، أو تنفيذاً لأمر، أو بعلم وتغاضي قادتهم العسكريين، وحتى لا يتملَّص أي شخص من مسؤولية المشاركة أو الفشل في منع أعمال الإبادة والتعديات الجماعية. وإن هذه الجرائم تختلف بطبيعتها وعناصرها عن الجريمة الإرهابية الفردية التي استهدفت الرئيس الحريري والتي هي من اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان، كما جرى توصيفها من قبل مجلس الأمن والاتفاق الثنائي، وليست بالتالي جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب أو إبادة. ومن جهة ثانية، إن هذه المسؤولية المفترضة، أي مسؤولية الرئيس عن أفعال مرؤوسيه غير منصوص عليها في الاتفاقية الثنائية التي اعتمدت فقط بعض المواد من قانون العقوبات اللبناني المفروض تطبيقها من قبل المحكمة الخاصة بلبنان، ولا في المعاهدات الدولية التي أبرمتها الدولة اللبنانية وأصبحت بقوة القانون الوطني.
لذلك وعملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وقاعدة عدم رجعية النصوص القانونية الجنائية الموضوعية، لا يجوز اعتماد قاعدة مسؤولية الرئيس عن أفعال مرؤوسيه الجرمية المشار إليها أعلاه وغير المنصوص عليها في القوانين اللبنانية عند حصول الجريمة والمستحدثة بموجب الاتفاق الثنائي لإنشاء المحكمة الخاصة لتطبيقها على جريمة اغتيال الرئيس الحريري المرتكبة قبل بدء نفاذ هذا الاتفاق.
ورداً على السؤال الذي يُطرح عن سبب اعتماد قاعدة مسؤولية الرئيس الجنائية عن أفعال مرؤوسيه في الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان والتي لا علاقة لها بالجرائم ضد الإنسانية، يمكن الجواب بأن نية واضعي الاتفاق الثنائي من فريق الأمم المتحدة والفريق اللبناني، هي استعمال المحكمة الخاصة، كأداة ضغط وتهديد ضد رؤساء أحزاب أو زعماء سياسيين لبنانيين، والنيل منهم، لتحميلهم المسؤولية عن الجريمة المذكورة وليس لإحقاق الحق والوصول إلى العدالة.
وما يؤكد ذلك أن بعض وسائل الإعلام العربية والأجنبية تضمنت معلومات عن إمكانية توجيه الاتهام فقط إلى عناصر أو أفراد في مجموعات حزبية لبنانية، وعسكريين تابعين لدول إقليمية، للتخفيف من وقع القرار الاتهامي على الرأي العام اللبناني في حال صدوره، إلا أن هذا الأمر يخفي في طيّاته مناورة هدفها الوصول في مرحلة لاحقة إلى اتهام كبار المسؤولين الحزبيين وإلى قادة هذه الدول، كما حصل سابقاً في محاكم يوغوسلافيا ورواندا وكمبوديا. وهذا ما يعرف بالطريقة المتدحرجة في تقنية المحاكم الدولية، إذ أنه من الممكن كما هو مبيَّن في قواعد الإجراءات والإثبات العائدة للمحكمة الخاصة بلبنان، أن يوجّه المدعي العام اتهاماً على دفعات، كما حصل سابقاً في محكمة يوغوسلافيا.
وهذا هو السبب الرئيسي الذي حمل واضعي اتفاقية المحكمة على وضع قاعدة مسؤولية الرئيس عن مرؤوسيه التي لا تطبق إلا على الجرائم ضد الإنسانية، كما سبق ذكره رغم معرفتهم بالواقع القانوني لهذه القواعد، وعدم إمكانية تطبيقها لا من قريب أو من بعيد على الجريمة الإرهابية الفردية التي أودت بحياة الرئيس الحريري. وهذا الأمر يفرض على الحكومة اللبنانية منعاً ودرءاً للفتنة أن تطلب من الأمم المتحدة تعليق العمل بهذه المواد استناداً للمادة العشرين من اتفاقية المحكمة، وإعادة النظر بها تمهيداً لتصحيح المسار القانوني لهذه المحكمة بالنسبة للقواعد المذكورة إنسجاماً مع مبادئ ومعايير العدالة الجنائية الدولية.
جيم: عدم احترام قوة القضية المحكوم بها للأحكام الصادرة عن القضاء اللبناني من قبل المحكمة الخاصة بلبنان
أجازت المادة الخامسة فقرة (2) من نظام المحكمة الخاصة، محاكمة أي شخص سبق أن تمت محاكمته أمام محكمة لبنانية، وصدر بحقه حكم عن أي فعل جرمي داخل اختصاص المحكمة في حال كان هذا الحكم قضى ببراءته وحتى في حال قضى بتجريمه وإنزال عقوبة بحقه، وذلك اذا قدرت المحكمة الخاصة، ان القضاء اللبناني الذي حاكمه يفتقر الى اعتبارات الحياد، أو أن الادّعاء اللبناني لم يكن قد أدَى دوره بالعناية الواجبة! وهنا يقتضي التأكيد أن الحكم القضائي اللبناني عندما يصبح نهائياً ويكون له قوة القضية المحكمة يرتب حقوقاً مكتسبة لمن صدر الحكم بوجهه، ولا يجوز لأي جهة المساس بهذه الحقوق بآثار رجعية إلا بموجب نص قانوني، كما أن عدم احترام قوة القضية المحكمة للأحكام الصادرة عن القضاء اللبناني وباسم الشعب اللبناني، يخالف المادة العشرين في الدستور اللبناني الذي يولي للمحاكم اللبنانية لوحدها حق اصدار الأحكام باستقلالية تامة، وبالتالي فإن التعرض للأحكام القضائية يخالف الدستور ويمسّ بالسيادة الوطنية، الأمر الذي يستوجب تعديل الدستور وفقاً للأصول القانونية لاعتماد امكانية محاكمة الجرم مرتين المشار اليها في المادة الخامسة فقرة (2) المذكورة أعلاه.
كما انه من ناحية ثانية، ان المادة 181 من قانون العقوبات اللبناني، تمنع ملاحقة الجرم الواحد الا مرة واحدة، وهذه القاعدة تعتمدها معظم الأنظمة القانونية لا سيما الفرنسي والبريطاني والأميركي.
ويقتضي الملاحظة أن الأحكام الواردة في المادة الخامسة فقرة (2) هي أحكام استثنائية سبق أن اعتمدت في نظام المحاكم الجنائية الدولية المحضة (يوغوسلافيا سابقاً وراوندا)، ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي تمارس اختصاصها على جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، باعتبار ان هذه الجرائم شديدة الخطورة وتثير قلق المجتمع الدولي بأسره ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من العقاب.
أما بالنسبة للأفعال الجرمية التي هي من اختصاص المحكمة الخاصة، فإنها جرائم فردية إرهابية وليست بجرائم حرب او إبادة أو جرائم ضد الإنسانية، كما أنه لم يصدر أي قرار اتهامي عن القضاء اللبناني في أي من هذه القضايا، وللمحكمة الخاصة سلطة الإطلاع على التحقيقات والإجراءات القضائية التي يقوم بها القضاء اللبناني في هذه الجرائم التي هي من اختصاص المحكمة الخاصة، والطلب إذا شاءت من هذا القضاء التنازل عن اختصاصه لمصلحتها سنداً للمادة الرابعة من نظام المحكمة.
لذلك يكون إيراد هذه الأحكام في نظام المحكمة الخاصة عديم الجدوى، وهناك خوف من أن يكون الهدف من اعتماد هذا المبدأ، هو توسيع اختصاص هذه المحكمة لتشمل جرائم سبق أن صدرت فيها أحكام قضائية مبرمة عن السلطة القضائية اللبنانية، لا تناسب بعض المراجع الدولية، ويراد إجراء الملاحقة بها مجدداً عن طريق التذرع بأن هذه القضايا لم تنظر بإتقان من قبل القضاء اللبناني ولم تكن إجراءات المحاكمة الوطنية محايدة أو مستقلة.
IV- وجوب استئخار النظر في دعوى جريمة اغتيال الرئيس الحريري ووقف أعمالها لحين تحديد المرجع القضائي الصالح للنظر في دعوى جرائم شهادة الزور والافتراء والبت بالدعوى المتعلقة بهذه الجرائم
نصت المادة الرابعة فقرة أولى من نظام المحكمة الخاصة بلبنان أن للمحكمة الخاصة وللمحاكم الوطنية في لبنان إختصاصاً مشتركاً، وتكون للمحكمة الخاصة ضمن اختصاصها اسبقية على المحاكم الوطنية.
ونصت المادة الثالثة من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي ترعى أعمال المحكمة أن تفسير هذه القواعد يتم وفقاً لروحية نظام المحكمة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي ولقانون الإجراءات الجزائية الدولي واللبناني.
ألف ـ تلازم جرائم شهادة الزور والافتراء المشتبه ارتكابها لدى لجنة التحقيق الدولية والقاضي العدلي اللبناني مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري
- بتاريخ 29/4/2009، صدر قرار قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة الخاصة بلبنان السيد فرانسين المستنِد إلى طلب المدعي العام الدولي القاضي بيلمار في قضية اغتيال الرئيس الحريري، فوافق على الإفراج عن الضباط الأربعة المحتجزين من قبل القضاء اللبناني منذ 30/8/2005 استناداً إلى توصية رئيس لجنة التحقيق الدولية السيد ميليس، وتضمن هذا القرار ما خلاصته أن إفادات الأشخاص التي تم توقيف الضباط على إثرها غير صادقة وإن المعلومات الموجودة في ملف التحقيق حول التورط المحتمل لهؤلاء الضباط في الهجوم على الرئيس الحريري غير موثوق بها كفاية لتبرير إيداع قرار اتهام بحق أي متهم.
- يتبيَّن أن هذا القرار يشير إلى أن بعض الأشخاص ارتكبوا إحدى الجرائم التالية: الإدلاء بشهادة الزور للتعمية عن الحقيقة أو الافتراء عن طريق إعطاء معلومات كاذبة ونسبتها إلى أشخاص محدّدين يعرفون براءتهم منها. وتعتبر هذه الجرائم التي ارتكبت لإخفاء نتائج جريمة اغتيال الرئيس الحريري أو لإبقاء منفذيها من دون ملاحقة، جرائم متلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري سنداً للمادة 133 من قانون أصول المحاكمات اللبناني لوجود رابطة معينة تجمع بينها من دون أن تؤدي إلى امتزاجها بحيث تبقى كل منها جريمة مستقلة. إلا أنه يقتضي بموجب القانون المذكور إحالتها معاً إلى مرجع جزائي واحد، وإن يكن غير صالح بالنسبة إلى بعضها وغاية ذلك تأمـين حسن سير العدالة.
باء ـ تنازل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن اختصاصها للنظر في جرائم شهادة الزور والافتراء
إن العناصر القانونية للجرائم المتلازمة متوافرة بين جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وهذه الجرائم المرتكبة لتضليل التحقيق ولإبقاء منفذي جريمة إغتيال الرئيس الحريري ورفاقه من دون ملاحقة لوجود رابطة وثيقة تجمع بينها، مما يستوجب إيلاء المحكمة الدولية الخاصة صلاحية النظر بجرم شهادة الزور لحسن سير العدالة. وما يعزِّز هذا الرأي أن نظام المحكمة الدولية يعطيها الأسبقية لاختصاصها على اختصاص المحاكم اللبنانية، وإن للمدعي العام الدولي، استناداً لنظام المحكمة الدولية، الصلاحية الواسعة للتحقيق مع كل الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الخاصة. وقد كرست القواعد الإجرائية المطبقة من قبل المحكمة الصلاحية الشاملة للمدعي العام الدولي لتولّي أي تحقيق له علاقة بقضية اغتيال الرئيس الحريري وفقاً للأصول القانونية الواجبة التطبيق.
إلا أن المفارقة، أن المدعي العام الدولي، بدلاً من أن يجري التحقيقات والملاحقات في جرائم شهادة الزور والافتراء التي هي من اختصاص المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وفقاً لما تقدم ذكره، عمد مكتبه إلى إصدار عدة تصريحات أيّدها هو بنفسه، أنه غير معني وغير مختصّ للتحقيق والملاحقة في جريمة شهادة الزور، أو المعلومات الكاذبة التي أُدلي بها أمام القضاء اللبناني، أو لجنة التحقيق الدولية، وقت كان القانون اللبناني المتعلق بالإجراءات والملاحقة هو المطبَّق على كل الأعمال التي كانت تجريها لجنة التحقيق الدولية التي كان يرأسها مؤخراً قبل أن يصبح مدعياً عاماً للمحكمة، ومتذرعاً بأن أحكام ملاحقة جريمة شهادة الزور المعني بها هي فقط المنصوص عليها في المادة 152 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وتتناول فقط شهادة الزور بعد حلف اليمين المدلى بها أمام إحدى غرف هذه المحكمة الدولية.
إن موقف المدعي العام الدولي المذكور يفيد أن المحكمة الدولية لا تريد ممارسة اختصاصها في ملاحقة هذه الجرائم المتفرعة والمتلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري كما بيًّنا أعلاه، ويُصبح بالتالي القضاء اللبناني حكماً صاحب الاختصاص لملاحقة هذه الجرائم سنداً لأحكام المادة الرابعة من نظام المحكمة المشار إليها أعلاه، ولقانون العقوبات اللبناني، لا سيما المادة الخامسة عشرة منه، التي تولي صلاحية المحاكم اللبنانية النظر في هذه الجرائم باعتبار أنها ارتكبت في الأراضي اللبنانية وفقاً لأحكام هذه المادة التي تنص على أنه تعد الجريمة مقترفة في الأراضي اللبنانية إذا تم على هذه الأراضي أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو فعل من أفعال جريمة غير مجتزأ، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي، كما إذا حصلت النتيجة في الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيها.
جيم- المرجع القضائي اللبناني المختص للنظر في جرائم شهادة الزور والافتراء
بسبب الخلاف الذي نشأ حول أصول إحالة ملف شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس الحريري إلى القضاء اللبناني والمرجع القضائي المختص للنظر فيه، كلف مؤخراً مجلس الوزراء وزير العدل إبراهيم نجار درس الملف وتقديم تقرير حول هذا الموضوع. ورأى واضع التقرير أن ملاحقة جريمة شهود الزور هي من اختصاص القضاء العادي وليس من صلاحية المجلس العدلي. ولتاريخه لم يتخذ مجلس الوزراء قراراً في هذا الموضوع لوجود خلافات حادة بين فريقين في الحكومة، مع الإشارة إلى أن مجلس الوزراء له حصرياً الحق بإحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي إذا إرتأى ذلك، وسنداً للمادة 355 أصول محاكمات جزائية، من دون أن يكون له الاختصاص بإحالتها إلى أي مرجع قضائي عادي، عملاً بمبدأ فصل السلطات. وتوضيحاً لهذا الموضوع، نبدي ما يلي:
إن جريمة اغتيال الرئيس الحريري أحيلت إلى المجلس العدلي بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء آنذاك، وتضمن هذا القرار إحالة جريمة اغتيال الرئيس الحريري وكل ما يتفرع عنها إلى المجلس العدلي. ويكون هذا المجلس بالتالي المرجع القضائي المختص للنظر بجرائم شهادة الزور والافتراء كونها متلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري وفقاً للمادة 133 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما ذكرنا سابقاً. وأنه لحسن سير العدالة، وحتى لا يبقى الفاعلون الحقيقيون لجريمة نالت من رئيس وزراء لبنان من دون ملاحقة تؤدي إلى توقيف الفاعل الأساسي، فإنه يقتضي إيلاء هذه القضية المتفرعة عن القضية الأصلية إلى قاضي التحقيق العدلي كون التحقيقات والمستندات والأدلة لا تزال موجودة في دائرته، ولأنه المرجع الأصلح والأفضل لتولّي النظر في هذه الجرائم. لذلك يقتضي على المحقق العدلي الذي كان واضعاً يده على ملف اغتيال الرئيس الحريري أن يباشر تحقيقاته في هذه الجرائم.
دال ـ وجوب استئخار البت في دعوى جريمة اغتيال الرئيس الحريري لحين البت بدعوى جرائم شهادة الزور والافتراء بعد وضع القضاء اللبناني يده عليها
تطبيقاً للمادة الرابعة من نظام المحكمة المذكورة أعلاه وللمبادئ الجنائية العامة ولقواعد الإجراءات الجزائية الدولية واللبنانية التي ترعى عمل المحكمة الخاصة بلبنان، يوجد تواصل وتعاون قضائي مستمر بين هذه المحكمة، والمحاكم الوطنية الواضعة يدها على الدعاوى التي تدخل في الاختصاص المشترك، بحيث أنه على المحاكم الوطنية إطلاع المحكمة الدولية على التحقيقات التي تجريها في الدعاوى ذات الاختصاص المشترك.
وفي إطار هذا التعاون يتوجب على قاضي التحقيق العدلي أو أي مرجع قضائي عادي ينظر في ملف جرائم شهادة الزور والافتراء في قضية اغتيال الرئيس الحريري إطلاع المحكمة الخاصة على هذه التحقيقات التي يجريها، كون هذه الجرائم متلازمة ومتفرعة عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري، وتدخل في الاختصاص المشترك، وقد تؤثر على نتيجة الدعوى الأصلية، كما أنه على المرجع القضائي المذكور الطلب من المحكمة الدولية وفقاً للأصول المعتمدة للتخاطب استئخار السير بدعوى جريمة اغتيال الرئيس الحريري، لحين البت في دعوى جرائم شهادة الزور والافتراء المتلازمة معها، والتي أدَّت إلى تضليل التحقيق، وحجبت الحقيقة عن هوية الفاعل الحقيقي، عن أنظار فريق التحقيق الدولي والادّعاء العام والمحكمة بكافة هيئاتها، والمساهمين معه في ارتكاب هذه الجريمة النكراء، وأخلَّت بسير العمل القضائي، وعطَّلت إمكانية توصله إلى معطيات وحقائق تقود إلى جلاء الحقيقة ومعرفة الفاعل لسوقه إلى العدالة.
ونرى أنه على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستجابة لطلب القضاء اللبناني ووقف أعمالها وتقرير استئخار النظر بدعوى اغتيال الرئيس الحريري، لحين البتّ بدعاوى جرائم شهادة الزور والافتراء المتلازمة مع الدعوى الأصلية، لما قد تؤثر نتيجتها على هذه الدعوى ولحسن سير العدالة وتطبيقاً لقاعدة اختصاص هذه المحكمة المشترك مع القضاء اللبناني المعتمد في نظام المحكمة وقواعدها الإجرائية.
وفي الختام،
وبعد أن ظهر للجميع أن القرار 1757/2007 لم يحترم بنود ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وبعد أن ظهر عدم احترامه لاستقلال لبنان وسيادته بإقراره الإتفاقية الثنائية للمحكمة الخاصة بلبنان تحت الفصل السابع للسماح للحكومة اللبنانية الفاقدة للشرعية واللاميثاقية آنذاك، بإجراء الاتفاقية من دون اتباع الإجراءات الدستورية اللازمة لإبرام الاتفاقيات الدولية وفقاً للدستور اللبناني كي تصبح هذه الاتفاقية نافذة، وبالتالي أجرى مجلس الأمن اتفاقاً مع نفسه وحلّ مكان الدولة اللبنانية في هذا الأمر وأنشأ محكمة هجينة لا تصنيف لها في نوعية المحاكم الدولية السابقة بحيث لا يُعرف ما إذا كانت محكمة ذات طابع دولي أو محكمة دولية محضة، ولا تُعرف القواعد القانونية الواجب تطبيقها عليها، أو الأحكام اللازم إخضاعها لها، وبحيث لا يمكن تحديد القاعدة الواجب مراعاتها لتكوين هذه المحكمة، وتعيين قضاتها، وكيفية عملها، وآلية تمويلها، والقانون الصائب الواجب تطبيقه.
لذا فإن اتباع هذه الطريقة يتيح المجال للبنان ودرءاً للفتنة عن نسيج مجتمعه، أن يصار إلى إعادة النظر في مقومات هذه المحكمة وقرار وضعها موضع التنفيذ، وأن تبادر الحكومة اللبنانية وسنداً للمادة العشرين من اتفاقية المحكمة مخاطبة الأمم المتحدة طالبة منها تصويب الخطأ الذي اعترى إنشاء هذه المحكمة، وإعادة النظر بتكوينها بأن يكون قضاتها بمجملهم دوليين إذا اعتُبرَت محكمة دولية محضة، أو مختلطين إذا اعتُبرَت ذات طابع دولي، وأن تَسحب قضاتها من هذه المحكمة إذا اعتُبرَت محكمة دولية صرفة طالما أنها وضعت تحت الفصل السابع، وأن يصار إلى تمويلها من قبل الأمم المتحدة باعتبارها هيئة فرعية للأمم المتحدة وفقاً لنص المادة التاسعة والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة، وخاضعة لسلطة مجلس الأمن. وقد صدقت المقولة السائدة &laqascii117o; رُبَّ ضارَّة نافعة".
- 'النهار'
شمال الغجر لبناني مشمول بالخط الأزرق وسكّانه سوريون ومزارع شبعا تستدعي وثائق وترسيماً لشرعنة لبنانيتها
تحقيق: إبراهيم حيدر:
عادت قضية قرية الغجر المحتلة الى الواجهة، بعدما قرر المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر في 17 تشرين الثاني سحب قواته من الجزء الشمالي للقرية، من دون أن يحدد موعداً للانسحاب، مشترطاً ان تكون المنطقة في عهدة اليونيفيل، إضافة الى اعتراف دولي بتطبيقه القرار الدولي الرقم 1701.
لكن القرار الاسرائيلي بالانسحاب من الجزء الشمالي لقرية الغجر لا يعيده الى السيادة اللبنانية، بفعل الشروط الاسرائيلية، كما ان هذا الانسحاب لا يكتمل من دون خروج الجيش الاسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والتي حضرت بقوة منذ العام 2000، تاريخ الانسحاب من الشريط المحتل.
واذا كانت قضيتا مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وضعتا على الرف منذ العام 2006، فإن قضية قرية الغجر المحتلة، بقيت حاضرة بفعل موقعها الجغرافي، وكونها تتداخل بالأراضي اللبنانية، باعتبار ان الغجر المحتلة هي سورية في الأساس وتقع في الطرف الشمالي الشرقي لهضبة الجولان المحتلة، حيث توسعت لتشمل أراضي لبنانية سيطرت عليها اسرائيل.
في ملف الغجر، رفض لبنان في العام 2009 اقتراحاً يقضي بوضع الشق اللبناني المحتل من القرية في عهدة القوات الدولية (يونيفيل) بعد انسحاب اسرائيل منها، مصراً على وضعها تحت السيادة اللبنانية من خلال انتشار الجيش اللبناني فيها، ودعّم لبنان موقفه بوثائق ترسيم الخط الأزرق ما بين لبنان واسرائيل والتي تشير الى ان قسماً من قرية الغجر لبناني وينبغي استرداده. وتبقى هذه القضية عالقة، وتشكل مصدر توتر مستمر على الحدود طالما بقيت محتلة، وهي المنطقة الوحيدة التي لا تزال محتلة مع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتشكل خرقا واضحاً وعلنياً للقرار 1701.
قرية الغجر
احتلت إسرائيل قرية الغجر مع احتلالها هضبة الجولان السورية المتاخمة في العام 1967، ولم تكن القرية ممتدة في اتجاه الشمال اللبناني. وبموجب الخط الأزرق للحدود اللبنانية أصبح شمال الغجر جزءاً من لبنان، مما ترك الجزء الجنوبي تحت سيطرة إسرائيل.
وأخلت إسرائيل شمال الغجر في العام 2000 عندما أنهت احتلالها لجنوب لبنان الذي استمر 22 عاماً، لكن لبنان لم يستعد سيادته الا على تخوم القرية، قبل ان تعاود احتلالها مرة أخرى خلال حرب تموز العام 2006، ولم تنسحب منها.
وحتى حزيران 1967 كانت القرية تخضع للإدارة السورية، وإن كانت مشكلتها أكثر تعقيداً منذ تحديد الحدود اللبنانية – الفلسطينية - السورية في العام 1923، وفي اتفاق الهدنة العام 1949، إذ تارة كانت تعتبر لبنانية وتارة أخرى سورية وثالثة مشتركة، الى ان حسمت سوريتها نهاية خمسينات القرن الماضي. ويقال انه عندما احتلت إسرائيل منطقة الجولان من سوريا في العام 1967، لم تدخل اولاً الى قرية الغجر لاعتبارها لبنانية، رغم ان لبنان لم يكن يمارس سيادته عليها.
وحين احتلت اسرائيل المنطقة الحدودية من لبنان في العام 1978، توسعت الغجر شمالا داخل الأراضي اللبنانية. ومنحت اسرائيل سكان الغجر الجنسية الاسرائيلية في عام 1981، بعدما قرر الكنيست الاسرائيلي من خلال 'قانون الجولان' ضّم الجولان الى دولة اسرائيل.
وبعدما انسحبت اسرائيل من الجنوب في 2000، شمل الخط الأزرق الجزء الشمالي من الغجر، فاضطرت اسرائيل الى إخلائه من دون ان يدخله الجيش اللبناني الذي لم يكن قد انتشر بعد في الجنوب، ولذلك فإن الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر، لا يرتبط فقط بالقرار 1701، انما يتعلق بالقرار 425 أيضاً والانسحاب يعيد الوضع الى ما كان عليه قبل العام 2006، وهي المنطقة الوحيدة التي لم ينسحب منها بعد عدوان تموز، أما انسحابه فلا يحل المشكلة نهائياً لأن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال تحت الاحتلال.
مزارع شبعا وتلال كفرشوبا
كانت مزارع شبعا حتى 25 أيار العام 2000، غائبة عن القاموس اللبناني المقاوم في نسخاته المتنوعة ولا تندرج في مفرداته، فالتركيز كان منصباً على منطقة الشريط الحدودي المحتل منذ 1978، والذي توسعت حدوده بعد العام 1982، اذ كان القرار الدولي الرقم 425 يلحظ حدود الخط الممتد من الناقورة وصولاً الى تلال كفرشوبا في العرقوب بمساحة تقارب الألف كيلومتر مربع.
ولأن مزارع شبعا لبنانية تاريخياً، كما يؤكد تاريخ المنطقة وروايات أهالي العرقوب ومرتفعات جبل الشيخ، لم يكن يتذكرها سوى اللبنانيين المعنيين مباشرة بها، بفعل علاقتهم بأرضها والمساحات المثمرة من الأراضي التي يملكونها فيها بحجج غير مسجلة رسمياً في الدوائر العقارية اللبنانية. فأراضي هذه المنطقة غير ممسوحة من الدوائر العقارية اللبنانية، وهو ما شكل ثغرة في الخرائط الرسمية الموجودة بحوزة لبنان، والنسخ المختلفة الموجودة في دوائر الأمم المتحدة المختصة وبعض الدول الكبرى، وخصوصاً في الخارجية الفرنسية.
بدأت قضية مزارع شبعا تظهر الى العلن وتبرز بقوة الى الواجهة بعد تحرير المنطقة المحتلة من الجنوب وتحديد الخط الأزرق طبقاً لوثائق اتفاق هدنة 1949. فتركز نشاط المقاومة في منطقة المزارع وتلال كفرشوبا، تحت عنوان ان هذه الأراضي لبنانية وينبغي تحريرها من الاحتلال الاسرائيلي، وان القرار 425 لم يكتمل تطبيقه طالما ان مزارع شبعا محتلة، وهو ما يعطي مشروعية لاستمرار المقاومة. وتناغمت الدولة اللبنانية والحكومات المتعاقبة منذ العام 2000 حتى عام 2005 مع هذا التوجه.
وفي معزل عن النقاش الدائم حول وظيفة المقاومة ودورها، وبصرف النظر عن أحقية طرح الأسئلة حول المنطقة، وحسابات الجدوى والمصالح الوطنية اللبنانية، خصوصاً بعد حرب تموز وصدور القرار 1701، فإن الأمر يستدعي التوقف فعلاً أمام خصوصية مزارع شبعا، في ضوء التأكيد اللبناني على استمرار العمل بمختلف الوسائل لتحرير ما تبقى من أراض محتلة في الجنوب اللبناني.
احتلال المزارع
احتل معظم مزارع شبعا في العام 1967، عندما كانت المنطقة خاضعة للسيطرة السورية بموافقة لبنانية. وقد وضعت سوريا مخافر في المزارع بطلب لبناني بعد عام 1958 لمنع التهريب، علماً أنها كانت تقر بلبنانيتها. ودفع احتلال الجولان السوري المحاذي للمزارع بالأمم المتحدة الى الحسم في ادراجها تحت القرار 242، من دون بروز اي موقف لبناني يسمح بإبقاء منطقة المزارع في الخارطة اللبنانية، اذ كانت هناك خشية من ان تضع أي مطالبة بذلك لبنان أمام متطلبات الصراع العربي – الاسرائيلي وانعكاساته. ولكن بعد العام 2000 اعتبرت الحكومة اللبنانية ان المزارع مشمولة بالقرار 425، من دون أن تعطي الوجه القانوني لذلك، ما أدى الى تعارض حقيقي وحاد بين النظرتين.
ومنذ تحرير القسم الأكبر من الجنوب اللبناني، أو معظم الشريط الحدودي باستثناء مزارع شبعا وبعض تلال كفرشوبا، لم يقدم لبنان، ولا يملك، لسوء الحظ، حتى الآن العدة اللازمة والوثائق القانونية الرافعة لتغيير نظرة الأمم المتحدة، واستطراداً المجتمع الدولي من قضية المزارع، بصرف النظر عن النقاش في مشروعية المقاومة، وهو أمر لم يكن بارزاً عند التدقيق في خط الانسحاب الاسرائيلي على طول الحدود الجنوبية، اذ يملك لبنان الاثباتات الضرورية والخرائط في شأن خط &laqascii117o;بوليه – نيوكامب" العام 1923، وخط الهدنة للعام 1949، ما مكنه من استعادة ملايين الأمتار المربعة عند وضع الخط الأزرق عام 2000، رغم تحفظه عن عدد من النقاط الحدودية.
واذا كانت قضية الحدود المرتبطة بالخط الأزرق تبقي ملف الحدود مفتوحاً، فهناك أراض لبنانية لا تزال وراءه، وبينها أراضٍ في قاطع كفرشوبا، كما إن للحديث عن مزارع شبعا معنى مختلفاً، ففي حين أنه لا يوجد خلاف داخلي حول لبنانية المزارع، وان هذا الخلاف يظهر في الشق المتعلق بالخيارات المتاحة، وما اذا كانت تحظى بإجماع اللبنانيين بعد انجاز التحرير، ومعها حسابات الكلفة والفاعلية في اطار ما تبقى من الصراع مع اسرائيل على المستوى العربي، فإن استكمال الملف اللبناني حول المزارع تجاه المجتمع الدولي، وربما تجاه الداخل اللبناني، يعيد نسب المزارع الى القضية الوطنية اللبنانية، علماً ان عدوان تموز، لم تكن مزارع شبعا شرارته الرئيسة.
ويحق للبنان تأكيد لبنانية مزارع شبعا، كما يحق له اعتبار القرار 425 الذي صدر في آذار العام 1978 نص على الانسحاب الاسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية المحتلة، ويحق له أن ينظر الى أي قطعة أرض محتلة مهما صغرت مساحتها من منطلق سيادي، لكن منطقة المزارع، التي لها وضع خاص منذ العام 1967 ، والتطورات التي حصلت فيها، تفرض على لبنان اعادة النظر في طريقة تعاطيه مع هذه المسألة نحو تصويب الخلل القانوني المرتبط بملفها.
واذا كان اللبنانيون يشاهدون من وقت الى آخر دوريات قوات 'اندوف' الدولية تجوب منطقة المزارع اللبنانية امتداداً من الجولان السوري المحتل، كونهما تابعين لمسؤوليتها انطلاقاً من القرار 242، فإن ذلك لم يكن مستغرباً على المستويين الدولي والاقليمي، لأن قوة 'اندوف' التي ترابط على الخط الفاصل بين القوات السورية والقوات الاسرائيلية في الجولان تقوم بمهمتها الطبيعية، انطلاقاً من ان اتفاق فصل القوات الموقع العام 1974 بعد حرب الاستنزاف السورية في الجولان، لحظت حدودها منطقة المزارع، باستثناء مزرعة بسطرة، وهي آخر مزرعة احتلتها اسرائيل العام 1972.
على هذا، فإن احتلال مزارع شبعا حصل العام 1967، بدءاً بمزرعة 'المغر' التي تتداخل بين الحدود اللبنانية والفلسطينية والسورية، والتي تفصل منطقة المزارع عن وادي العسل السوري، وهي المزرعة الأولى التي احتلت في 10 حزيران 1967، ثم استولت اسرائيل في 15 حزيران على مزارع 'خلة غزالة' و'ظهر البيادر' و'رويسة القرن' و'جورة العقارب' و'فشكول' وهجرت معظم سكانها. وفي 20 حزيران من العام 1967، استكملت اسرائيل اجتياحها لمزارع 'قفوه' و'زبدين' و'بيت البراق' و'الربعة' و'برختا التحتا' و'برختا الفوقا' و'كفردورة' و'مراح الملالي'. وفي آب من العام نفسه احتلت مزرعة 'رمثا' وهجرت كل سكان المزارع وفجرت منازلهم. واكتمل احتلال المزارع العام 1972 باجتياح مزرعة بسطرة، فضمت مساحاتها المتبقية وسيّجت المنطقة بأسلاك شائكة ومكهربة.
موقف لبنان
لم يحدث احتلال مزارع شبعا ردود فعل رسمية لبنانية طوال تلك المدة، ولم تظهر في وثائق الأمم المتحدة أي شكوى رسمية لبنانية بين عامي 1967 و1974، رغم صدور قرارات للمنظمة الدولية تطالب اسرائيل باحترام أراضي لبنان وسيادته وتدعوها الى الانسحاب من أراض كانت اجتاحتها على طول الحدود الدولية من الناقورة الى كفرشوبا في ستينات وسبعينات القرن الماضي، أما الاشارة الوحيدة التي ظهرت رسمياً فهي من خلال عدد من النواب خلال مناقشات البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة في لبنان بين العامين 1968 و1974، والتي اقتصرت على المطالبة بإثارة موضوع احتلال اسرائيل للمزارع ومساعدة مهجريها والمهجرين من منطقتي القنيطرة والحولا في الجولان المحتل وشمال فلسطين الذين لجأوا الى بلدة شبعا، ومطالبة مجلس الجنوب آنذاك بالتعويض عن الأهالي الذين لم يكن قانون التعويض يلحظ ممتلكاتهم في المزارع، بعكس أهالي منطقة كفرشوبا وكفرحمام وراشيا والهبارية وشبعا.
مشكلة وثائق
وفي الواقع، لم يتوقف احتلال اسرائيل للمناطق المتاخمة للمزارع في تلك الحقبة في العرقوب على المزارع وحدها، بل امتد الى غير منطقة، خصوصاً في قاطع كفرشوبا، ولا تزال حتى الآن تحتل أجزاء منه، خصوصاً جبل الروس الذي يعرف بـ'رويسة العلم'، وهو عبارة عن تلة دارت معارك طاحنة حولها بين الفلسطينيين والاسرائيليين العام 1970، و'رويسة السماقة' و'مشهد الطير' وخراجات أخرى تمتد من كفرشوبا في اتجاه القنيطرة السورية. ويملك لبنان خرائط مفصلة لهذه الأراضي التي وردت في خرائط الحدود للعام 1943، باستثناء مزارع شبعا.
على ان هناك نقطة أخرى تتمسك بها الأمم المتحدة وتملك وثائق كافية حولها، وهي أن خط انتشار قوات الطوارئ الدولية 'اليونيفيل' الحالية في المنطقة الجبلية، المحاذية للمزارع وعلى الخط الأزرق، هو الخط نفسه الذي اتفق عليه العام 1978 بين لبنان والمنظمة الدولية، وهو الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تتمسك به وتصرّ عليه عند وضع الخط الأزرق بعد التحرير، من دون أن تفضي الاعتراضات اللبنانية والمتحفظة الى نتيجة ملموسة.
انطلاقاً من ذلك، تكون اسرائيل بدأت باحتلال المزارع العام 1967، واقتطعتها في شكل تام العام 1972، بعدما سوّرتها وأحكمت السيطرة عليها بطرد جميع من فيها، ثم عادت وثبتت قرار الضمّ مع صدور قرار عن القيادة الاسرائيلية العام 1989، رغم أن اسرائيل كانت لا تزال تحتل الشريط الحدودي بكامله حتى منطقة جزين، والقرار يلحق المزارع بقيادة الجولان وجبل الشيخ. ولم تنفع في رد ذلك تحركات وزارة الخارجية اللبنانية، التي أرسلت تعليماتها الى مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة بضرورة اجراء اتصالات لتأمين ضغط دولي من أجل وقف الضم الذي حصل منذ العام 1967 وأوجد واقعاً مختلفاً على الأرض عن واقع مناطق الشريط الحدودي الأخرى.
لم ينفِ احتلال اسرائيل لمزارع شبعا وضمها واندراجها في اتفاق فصل القوات العام 1972 بين سورية واسرائيل، لبنانية المزارع بالنسبة الى اللبنانيين عموماً، خصوصاً الجنوبيين منهم. والمعمرون الذين لا يزالون على قيد الحياة يروون ان سورية طلبت من لبنان منتصف الخمسينات من القرن الماضي العمل على وقف التهريب من هذه المنطقة الجبلية في اتجاه فلسطين المحتلة، عبر مثلث مغرسبكا اللبنانية – بانياس السورية - الحولة الفلسطينية. ولما لم تكن للبنان قدرة على ذلك، وضعت سورية مخافر أمنية في المنطقة بموافقة لبنانية، في حين اقتصر التدخل اللبناني على دوريات للجمارك اللبنانية كانت تحصي أعداد الماشية وتدقق في ما اذا كانت حصلت عمليات تهريب أم لا. ولذلك حين اجتاحت اسرائيل المنطقة لم تكن توجد في المزارع سوى قوات سورية، فنسبت الأمم المتحدة المزارع المحتلة الى القرار 242.
حاول لبنان التحرك من أجل اثبات لبنانية مزارع شبعا، وقدم خرائط محلية تثبت ملكية اللبنانيين لأراضي المزارع، مع حجج ملكية لعدد من اللبنانيين. وتبين أن الأمم المتحدة تملك خرائط عدة لا تشير الى لبنانية المزارع وتنسبها الى سورية ملحقة اياها بالجولان السوري المحتل. لكن تاريخ المنطقة يؤكد لبنانية المزارع التي كان يعيش فيها لبنانيون، وهي لا تتعدى بمجملها مساحة 40 كيلومتراً مربعاً، وهو ما يفترض تحركاً لبنانياً على غير مستوى واتفاقاً مع سورية يعيد تثبيت لبنانية المزارع بوثيقة ترفع الى الأمم المتحدة تعترف بلبنانية المزارع وتعطي الأمم المتحدة دفعاً لاعادة النظر في خرائطها واعادة ترسيم حدود المنطقة. وربما يستدعي ذلك طلباً من الأمم المتحدة لاستصدار قرار يساهم في اخراج اسرائيل من المنطقة، ومن خلال قضية الغجر يمكن شرعنة المطالبة اللبنانية باستعادة المزارع، بما يتجاوز الكلام الانشائي المتبادل حول لبنانيتها.