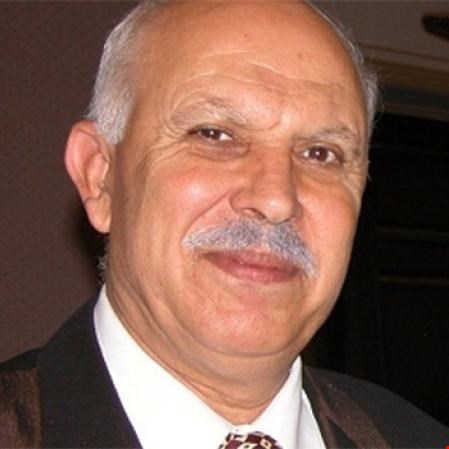قضايا وآراء » قضايا وآراء مختارة من الصحف اللبنانية الصادرة الإثنين 13/9/2010

- صحيفة 'الأخبار'
شهود الزور
خالد صاغية:
حاول القاضي دانيال بلمار ذات مرّة الفصل بين السياسي وغير السياسي في شأن المحكمة الدولية. كان ذلك حين سئل عن جرائم ومجازر جماعيّة لم تُنشأ من أجلها محاكم دوليّة، فيما المحكمة تقام اليوم من أجل اغتيال شخص واحد. ردّ بلمار آنذاك بما معناه أنّ قرار إنشاء المحكمة قد يكون سياسيّاً لكونه صادراً عن مجموعة دول مجلس الأمن، لكنّ عمل المحكمة شأن مختلف. فمنذ لحظة إنشائها، تستطيع المحكمة أن تمارس مهماتها باستقلاليّة تامّة عن السياسة.
لكنّ الوقائع التي تلت إنشاء المحكمة تترك أقلّه شكوكاً في ذهن أيّ مراقب محايد. وقد لا يكون ذلك بسبب فريق المحكمة نفسه أو الخروق الاستخباريّة الممكنة له، بل بسبب الظروف السياسيّة الشديدة التعقيد التي تعمل المحكمة في ظلّها. فلا يمكن مثلاً تخيُّل قرار يدين رأس نظام دولة ما (سوريا مثلاً)، في ظلّ عدم استعداد دوليّ لتغيير النظام في تلك الدولة. ولا يمكن تخيُّل قرار يدين جهة سياسيّة كبرى (حزب اللّه مثلاً)، في ظلّ عدم رغبة دولية في التخلّص من تلك الجهة، أو أقلّه الحدّ من نفوذها.
صحيح أنّه لا يمكن النظر إلى العدالة الدوليّة كمجرّد ألعوبة في أيدي الدول الكبرى، لكن، تماماً كما قيل ذات مرّة إنّ الحروب أشدّ خطورةً من أن تُترك للجيوش، فإنّ التوازنات الدقيقة في منطقة ملتهبة كالشرق الأوسط، هي أشدّ خطورة من أن تُترك لقرار اتّهاميّ يصدر عن محكمة دوليّة.
لذلك، يبدو &laqascii117o;تسييس" المحكمة قدراً أكثر منه فعلاً إرادياً. وهو تسييس يصيب المتّهِمين والمتّهَمين على حدّ سواء. فتماماً كما شاءت الصدف أن تُتّهم سوريا باغتيال الرئيس رفيق الحريري في زمن الهجمة الدولية على سوريا، ويُتّهم حزب الله في زمن الهجمة الدولية على سلاحه، كذلك بات ملفّ شهود الزور قضيّة مركزيّة لدى الجهة المقابلة.
والواقع أنّ هذا الملفّ، تماماً كالاتّهامات التي سبقته، لا يمكن إخفاء وجهه السياسيّ. الملفّ يمثّل دون شك ورقة قوية في وجه صدقيّة المحكمة، لكنّه مرتبط أيضاً باللعبة السياسيّة. فما لم تشأ المعارضة السابقة أن تناله قسراً بعد أحداث 7 أيّار، يراد اليوم أخذه تحت شعار &laqascii117o;شهود الزور". أي المطلوب، بكلّ بساطة، ليس تغيير الطاقم المحيط بالرئيس سعد الحريري وحسب، بل تفكيك &laqascii117o;دولة" فؤاد السنيورة أيضاً. إنّه نوع من تصحيح &laqascii117o;الحماقة" التي ارتكبت في الدوحة، حين جرت الموافقة على إعادة السنيورة نفسه إلى كرسيّ الرئاسة الثالثة مقابل تعديلات في زواريب الدوائر الانتخابيّة.
لقد بدأ سعد الحريري بتقديم التنازلات في دمشق. المطلوب أن يخلع ثيابه في بيروت.
- صحيفة 'النهار'
محور 'مع رمزية رحيل كامل الأسعد: علاقة الشيعة بالكيان بين الماضي والحاضر
فارس أشتي:
باشرت 'قضايا النهار' محوراً تحت عنوان 'مع رمزية رحيل كامل الأسعد: علاقة الشيعة بالكيان اللبناني بين الماضي والحاضر'.
بعد تقديم جهاد الزين (طائفة بين ارتباكين... ومغامرة كبرى- 25/8/2010)، ساهم طلال عتريسي (ماذا يريد الشيعة من دولتهم- 25/8/2010)، وسعود المولى (مشروع الإمام الصدر المستقبلي أصبح هو أيضاً من الماضي- 29/8/2010)، ونجاة شرف الدين (سوريــا والشيعــة اللبنانيون - 1/9/2010)، وطلال خوجة (لعنة الموقع- 3/9/2010)، والشيخ علي خازم (الشيعة بين 'الولاية' والمواطنة- 6/9/2010)، ومنى فياض ('أمل' المتأرجحة- 8/9/2010). اليوم يساهم فارس اشتي.
شهود الزور
خالد صاغية:
حاول القاضي دانيال بلمار ذات مرّة الفصل بين السياسي وغير السياسي في شأن المحكمة الدولية. كان ذلك حين سئل عن جرائم ومجازر جماعيّة لم تُنشأ من أجلها محاكم دوليّة، فيما المحكمة تقام اليوم من أجل اغتيال شخص واحد. ردّ بلمار آنذاك بما معناه أنّ قرار إنشاء المحكمة قد يكون سياسيّاً لكونه صادراً عن مجموعة دول مجلس الأمن، لكنّ عمل المحكمة شأن مختلف. فمنذ لحظة إنشائها، تستطيع المحكمة أن تمارس مهماتها باستقلاليّة تامّة عن السياسة.
لكنّ الوقائع التي تلت إنشاء المحكمة تترك أقلّه شكوكاً في ذهن أيّ مراقب محايد. وقد لا يكون ذلك بسبب فريق المحكمة نفسه أو الخروق الاستخباريّة الممكنة له، بل بسبب الظروف السياسيّة الشديدة التعقيد التي تعمل المحكمة في ظلّها. فلا يمكن مثلاً تخيُّل قرار يدين رأس نظام دولة ما (سوريا مثلاً)، في ظلّ عدم استعداد دوليّ لتغيير النظام في تلك الدولة. ولا يمكن تخيُّل قرار يدين جهة سياسيّة كبرى (حزب اللّه مثلاً)، في ظلّ عدم رغبة دولية في التخلّص من تلك الجهة، أو أقلّه الحدّ من نفوذها.
صحيح أنّه لا يمكن النظر إلى العدالة الدوليّة كمجرّد ألعوبة في أيدي الدول الكبرى، لكن، تماماً كما قيل ذات مرّة إنّ الحروب أشدّ خطورةً من أن تُترك للجيوش، فإنّ التوازنات الدقيقة في منطقة ملتهبة كالشرق الأوسط، هي أشدّ خطورة من أن تُترك لقرار اتّهاميّ يصدر عن محكمة دوليّة.
لذلك، يبدو &laqascii117o;تسييس" المحكمة قدراً أكثر منه فعلاً إرادياً. وهو تسييس يصيب المتّهِمين والمتّهَمين على حدّ سواء. فتماماً كما شاءت الصدف أن تُتّهم سوريا باغتيال الرئيس رفيق الحريري في زمن الهجمة الدولية على سوريا، ويُتّهم حزب الله في زمن الهجمة الدولية على سلاحه، كذلك بات ملفّ شهود الزور قضيّة مركزيّة لدى الجهة المقابلة.
والواقع أنّ هذا الملفّ، تماماً كالاتّهامات التي سبقته، لا يمكن إخفاء وجهه السياسيّ. الملفّ يمثّل دون شك ورقة قوية في وجه صدقيّة المحكمة، لكنّه مرتبط أيضاً باللعبة السياسيّة. فما لم تشأ المعارضة السابقة أن تناله قسراً بعد أحداث 7 أيّار، يراد اليوم أخذه تحت شعار &laqascii117o;شهود الزور". أي المطلوب، بكلّ بساطة، ليس تغيير الطاقم المحيط بالرئيس سعد الحريري وحسب، بل تفكيك &laqascii117o;دولة" فؤاد السنيورة أيضاً. إنّه نوع من تصحيح &laqascii117o;الحماقة" التي ارتكبت في الدوحة، حين جرت الموافقة على إعادة السنيورة نفسه إلى كرسيّ الرئاسة الثالثة مقابل تعديلات في زواريب الدوائر الانتخابيّة.
لقد بدأ سعد الحريري بتقديم التنازلات في دمشق. المطلوب أن يخلع ثيابه في بيروت.
- صحيفة 'النهار'
محور 'مع رمزية رحيل كامل الأسعد: علاقة الشيعة بالكيان بين الماضي والحاضر
فارس أشتي:
باشرت 'قضايا النهار' محوراً تحت عنوان 'مع رمزية رحيل كامل الأسعد: علاقة الشيعة بالكيان اللبناني بين الماضي والحاضر'.
بعد تقديم جهاد الزين (طائفة بين ارتباكين... ومغامرة كبرى- 25/8/2010)، ساهم طلال عتريسي (ماذا يريد الشيعة من دولتهم- 25/8/2010)، وسعود المولى (مشروع الإمام الصدر المستقبلي أصبح هو أيضاً من الماضي- 29/8/2010)، ونجاة شرف الدين (سوريــا والشيعــة اللبنانيون - 1/9/2010)، وطلال خوجة (لعنة الموقع- 3/9/2010)، والشيخ علي خازم (الشيعة بين 'الولاية' والمواطنة- 6/9/2010)، ومنى فياض ('أمل' المتأرجحة- 8/9/2010). اليوم يساهم فارس اشتي.
يثير عنوان الملف 'علاقة الطائفة الشيعية بالكيان اللبناني' تحفظين منهجيين:
الأول حول الطائفة الشيعية فهل هي واحدة مجتمعياً في لبنان؟ وهل شكلت كياناً قائماً بذاته فيه؟ وهل يقصد بالطائفة الشيعية عموم ابنائها، أم مرجعيتها الدينية؟ أم أولي الأمر فيها أم نخبها؟
الثاني حول علاقة الطائفة الشيعية بالكيان اللبناني، فهل شكّل الشيعة كياناً قائماً بذاته مقابل الكيان اللبناني لتقوم علاقة بينهما؟ أم أن الشيعة، كأفراد وجماعات وقيادات، انخرطوا في الكيان اللبناني لحظة تأسيسه وكانوا في حقله الاجتماعي السياسي الواحد؟
وعليه أرى:
1- إن الشيعة لحظة تأسيس الكيان ثلاثة تجمعات: الشيعة في الجنوب والشيعة في البقاع والشيعة في المتصرفية (ضواحي بيروت وجبيل) وكل منها منخرط في نمط انتاج مغاير للآخر وفي وحدات سياسية متباينة. ولم يغير وجودهم في الكيان الحديث من هذا التمايز الذي أنتج قيادات عديدة في كل تجمع من هذه التجمعات؛ طموح كل منها قيادة منطقة لا طائفة، كما انتج تمايزات طبقية في كل منها.
كما لم تسلّم هذه القيادات، ومعها ما انتشر بين الشيعة من احزاب تغييرية، بمحاولة السيد موسى الصدر توحيد الطائفة تحت قيادته ومشروعه ، فكانت موجودة في المجلس المذهبي للطائفة، وإن كان هو الأقوى بينها، وكانت فاعلة في الحرب اللبنانية، قبل تغييبه وبعده.
كما لم تسلس الانقياد لقيادة الثنائي 'أمل' - 'حزب الله' إلا في لحظات التأزم القصوى، فضلاً عن أنها قيادة ثنائية، رغم التقارب بينهما الذي فرضته الرعاية الاقليمية والتأزم.
2- إن استخدام تعيير الشيعة - أو الدروز أو الموارنة أو... - في تحديد موقف أو رأي من قضية ما غير دقيق، إلا إذا قام باستخدام استطلاعات رأي ودراسات ميدانية وسوسيولوجية، وقد يكون الأفضل - رغم عدم الدقة الكاملة - استخدام تعبير مرجعيات دينية إذا كان الأمر متعلقاً بقضايا دينية أو القيادات والنخب بين الشيعة في القضايا الأخرى ، وقد كانت المرجعيات والقيادات متعددة ومتباينة بينهم.
3- إن الشيعة كبقية الطوائف في لبنان في حقل اجتماع سياسي واحد هو الكيان (حسب تعبير الوحدويين) أو الدولة (حسب تعبير الآخرين) ولم يشكل أي منها كيانا قائماً بذاته في مواجهة الكيان - الدولة لتقوم علاقة بينهما، واقتصرت 'كيانية' الطوائف على لحظة تأسيس الكيان، التي كانت 'كيانات' وقيادات لا 'كياناً' - قائداً عند كل الطوائف، باستثناء الموارنة.
وقد كانت القيادات الشيعية بتجمعاتها الثلاثة في موقفها من الكيان لحظة التأسيس مشدودة بعامل استمراء الاستمرار على القديم من جهة وبعامل التوهم الايديولوجي بانتصار المشروع الفيصلي، من جهة ثانية.
إلا أن هزيمة فيصل واعلان الدول الكبرى دولة لبنان الكبير عدّل مواقف غالبية هذه القيادات، كما قيادات الطوائف الأخرى، ولم تكن المشاركة في الانتفاضات التي جرت ما بين 1920 و 1926 فاعلة وعامة بين هذه الطوائف، إذ اقتصرت على بعض المندفعين في الجنوب وبعلبك دون قياداتها ودروز وادي التيم، دون دروز جبل لبنان وقياداته.
وعليه لايصح القول:اعطونا دولة قوية وقادرة نعطكم السلاح، او ماذا يريد الشيعة من الدولة او غير ذلك من التعابير، وهي كثيرة، توحي بأن الشيعة 'كيان' مستقل خارج الدولة، وهي تعابير غير دقيقة من جهة، وتستبطن عند قائليها رغبة بذلك، من جهة اخرى.
4- إن مواقف وتوجهات النخب بين الشيعة في الكيان اللبناني ومنه مرت بمراحل متعددة:
- مرحلة ما بين اعلان دولة لبنان الكبير (1920) ومطلع السبعينات.
- مرحلة مطلع السبعينات حتى اتفاق الطائف.
- مرحلة الطائف حتى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.
- مرحلة ما بعد استشهاد الحريري.
ففي المرحلة الأولى، كان الغالب على الانتاج الطابع الزراعي في الجنوب والبقاع وطابع العمل في المعامل والمهن الدنيا في قطاع الخدمات في بيروت والضواحي، وكانت قيادات هذه التجمعات مناطقية وركائزها العائلات وبنيتها 'اقطاعية ' وقيمها قيم المجتمعات الزراعية .
ولم يكن قطاع الخدمات في بيروت وجبل لبنان المجاور لها قد توسع إلى الارياف الجنوبية والبقاعية وفي جبل لبنان والشمال. وقد كان توسع البنية التحتية لهذا القطاع، كهرباء وماء وتعليم، والذي شهد تطوراً نوعياً في العهد الشهابي مدعاة لنمو الاحزاب التغييرية فيها.
ففي الموقف من الكيان اجمعت القيادات التقليدية على القبول به واختلفت - كما في بقية الطوائف - على سياسات العهود المختلفة فانقسمت بين المحورين اللذين سادا (دستوري - كتلوي، ناصري - انعزالي، شهابي - شمعوني) وامتداداتهما الاقليمية والدولية ، ولم تكن مطالبات زعمائه المناطقية ذات الطابع الطائفي مغايرة لمطالبات زعماء الطوائف الأخرى، وأحياناً كان الطابع الطائفي لبعض المطالبات ذا طبيعة ايديولوجية، للتعبئة ولاخفاء مضمونه الفعلي، وقد غلب على هذه القيادات طابع الارتباط بالارض والارتكاز على العائلات والدعم من المرجعيات العليا للبلد.
وقد خرجت عن هذا الموقف النخب المنضوية في الاحزاب التغييرية، فكانت الأحزاب القومية (الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحركة القوميين العرب) رافضة للكيان، خطاباً على الأقل، باستثناء عهد كميل شمعون بالنسبة للأول، وكانت مع الاحزاب الاشتراكية والشيوعية معترضة على سياسات العهود المتلاحقة خارج اعتراض التقليديين.
وقد غلب على هذه النخب الطابع البورجوازي الصغير، اجتماعياً، والتنويري، فكرياً، إذ كانت بين المعلمين والطلاب وأصحاب المهن الحرة، فضلا عن العمال وصغار الكسبة في بيروت وضواحيها.
وفي المرحلة الثانية، حين توسع انتشار نظام الخدمات في الأرياف وأصبح الوجود الفدائي الفلسطيني فاعلاً في لبنان ومعه حضور لبنان في السياسة الدولية، او بالاحرى ازدياد حضور الدول الكبرى والاقليمي فيه، كلا الامرين كانا أكثر تأثيراً في المناطق ذات الوجود الشيعي (الجنوب، ضاحية بيروت الجنوبية، تل الزعتر) فتراجع الانتاج الزراعي ونخبه المنشدة إلى الأرض والانقسامات المحلية، وتقدمت النخب المنشدة إلى القضية والمنفتحة على الانقسامات الاقليمية.
وبرغم استمرار القيادات التقليدية بين الشيعة، في هذه المرحلة، على موقفها من الكيان وانخراطها في الثنائية السائدة في سياساته، فإنها تراجعت لمصلحة ثنائية جديدة:
&bascii117ll; قوى التغيير التي حملت مشروعاً لتغيير النظام السياسي الاقتصادي في لبنان وتخففت من قضية الموقف من الكيان، إذ كان مشروعها يضرب بنية الميثاق الوطني، ركيزة تميز الكيان.
&bascii117ll; مشروع السيد موسى الصدر الذي حمل قضية قوى التغيير، شيعياً، وحاول انتزاع القيادة منها، دون أن يصل إلى حدودها في ضرب بنية النظام الطائفي، لا بل عززه بنقل مطالب القيادات الشيعية المناطقية إلى مطلب الشيعة ككل مؤسساً لقيادة واحدة لطائفة واحدة ما أصبح السائد في ما بعد.
وقد تميزت الحرب اللبنانية تلك بضرب بنية الاقتصاد اللبناني من جهة، وبازدياد حدة الانقسام الطائفي، دفاعاً وحماية اوهجوماً، من جهة ثانية، وبازدياد الارتهان للخارج، اقتصادياً وسياسياً، من جهة ثالثة.
ولم يخرج الوضع في المرحلة الثالثة عن ذلك، إذ خرجت الانقسامات عن ضبطها الداخلي لتدخل في الحسابات الاقليمية، وقد تبدلت فيها معطيات اقليمية ذات تأثير:
&bascii117ll; انتصار الثورة في ايران ودعوتها للثورة الاسلامية في العالم وعملها لذلك.
&bascii117ll; حرب الخليج الأولى ضد العراق.
&bascii117ll; تفكك الكتلة السوفياتية وانهيارها وتحول دولها نحو الرأسمالية.
&bascii117ll; النزوع الاميركي الى الوحدانية في قيادة العالم .
&bascii117ll; محافظة النظام السوري على تماسكه وموقعه في ظل هذه المتغيرات.
وقد أدت هذه المعطيات، إلى تراجع قوى التغيير بصعود القوى الاسلامية وانضباط الوضع تحت الرعاية السورية، سياسياً وأمنياً، والسعودية، اقتصادياً ومالياً، للبنان، وبموافقة دولية، بشكل عام وأميركية، بشكل خاص.
وفي المرحلة الخامسة، التي اهتزت فيها الرعاية السورية للبنان وسُحب التوافق الدولي عنه، وارتفع منسوب التوتر الاقليمي والدولي، فيه وحوله،خرجت إحدى قوى الشيعة الاساسية من مكمنها القتالي ضد اسرائيل لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة إلى ساحة العمل السياسي العام منخرطة في المحور الايراني - السوري وإداة أساسية من أدواته، كما انخرطت قوى محلية أخرى في المحور السعودي - الاميركي.
وهكذا يمكن القول أن القوى بين الشيعة ونخبها المتعددة انتقلت من موقع الاحتجاج 'الاقطاعي' المناطقي على الحصة في النظام في الكيان، لا الكيان نفسه، ومن ضمن ثنائيته إلى موقع آخر اضيف إليه الاحتجاج الشعبي، شيعياً وطبقياً على النظام السياسي الاقتصادي - الاجتماعي، إن لاهمال مناطق الشيعة، عند البعض، أو لظلم طبقات وفئات مجتمعية، عند البعض الآخر، وذلك في حدود الكيان.
وشكلت الحرب اللبنانية وما تلاها وبخاصة اغتيال الرئيس الحريري وتأثيرات ذلك على نظام البلد، نقلة في موقع نخب الشيعة الفاعلة، وكذا النخب في الطوائف الأخرى، من الكيان، بانخراطها في اللعبة الاقليمية والدولية، بحيث لم يعد القول الايديولوجي بالمحافظة على الكيان، وصيغ حكمه المتوالية (الميثاق الوطني، اتفاق الطائف، اتفاق الدوحة) ذا ارجحية في سياساتها. وانتقلت معه طبيعة القيادة من قيادة يغلب عليها الطابع الاقطاعي والعلاقات المجتمعية العائلية والمشبعة، حقيقة او ادعاء، بقيم المجتمعات الزراعية الى قيادات يغلب عليها الطابع الخدماتي والعلاقات المجتمعية القائمة على الولاء الطائفي والمشبعة، حقيقة او ادعاء، بقيم المجتمعات الخدماتية.
وبهذا المعنى يمكن اعتبار كامل الاسعد رمزاً لمرحلة انقضت، بايجابياتها وسلبياتها، واعتبار القيادات الراهنة، بما فيها وارثو قيادات المرحلة السابقة، رموزاً لمرحلة الانتاج الخدماتي، اقتصاياً وسياسياً.
- صحيفة 'السفير'
الاستخبارات التركية: فضاءاتُ الأكَمةِ والتغيير الجديد
راكان المجالي:
... تبقى الإشارة الى أنّ مجمــوعات يهود &laqascii117o;المزراحي والدونما"، التي استوطنت في تركــيا خلال حقبة الإمبراطورية العثــمانية، بعد هــجرتها من إســبانيا، تلعب دوراً هاماً، في المؤسسات العســكرية والأمنية والاستخبارية التـركية. فقد استــطاع اليهود الأتراك التغلغل في داخل صفوف تلك الأجــهزة، وكذلك تمكــّنوا من الوــصول الى المواقع الأكثر حساســية وأهــمية، في جهاز الاستخبارات الوطني التركي. ما يعــني أنّ ذلك الجهاز هو جهاز مكشوف بالكامل أمام &laqascii117o;الموســاد" الإسرائيلي، وذلك بسبب مشـاعر الولاء المزدوج عند العناصر اليهودية، المتغلغلـة فيه، وتعاملها بشكل طوعي مع الموساد الإسرائيلي. فهل يفسّر ذلك طبيعة الهجمة العنيفة، التي تشنّها الدوائر الأمنــية الإسرائيـلية ضدّ مدير الاستخبارات الوطنية التركية الجـديد، أم أنّ وراء الأكمة أكثر مما يبدو أمامها، ويحجبه ضبابٌ اصطناعي كثيف؟.
ـ صحيفة 'الديار'
الى متى: العيد.. عيدان!
محمد السباعي ـ إعلامي:
بالرغم من التقدم الذي بلغه المسلمون في تحديث كثير من الامور والقضايا المتصلة بالحياة والعصر، مستفيدين من العلوم الحديثة ودقة انجازاتها، الا انهم بقوا حائرين ومرتبكين حول مسألة تحديد بدايات الاشهر الهجرية. وكان المرجع الديني (السيد محمد حسين فضل الله) رحمه الله، أول من اثار الجدل الفقهي والعلمي منذ أكثر من عشرة اعوام حين دعا الى الاعتماد على علم الفلك في تحديد مواعيد الآهلة، وبدأ يصدر بيانات شرعية تحدد بداية شهر رمضان وايام الاعياد قبل عشرة ايام من حلولها. وقد أثار(السيد فضل الله) حينها حفيظة كثير من المرجعيات الاسلامية السنية والشيعية، وقامت في وجهه حملات مضادة من بعض المرجعيات تتهمه بمخالفة رأي المشهور من المسلمين &laqascii117o;صم للرؤية والفطر للرؤية واياك والشك والظن".
وفي مؤتمر (علم الفلك) الذي دعت اليه (مؤسة الفكر الاسلامي المعاصر) في بيروت في الفترة ما بين 8 ـ 10 آذار (مارس) 2010 تحت عنوان &laqascii117o;جدلية العلاقة بين الفلك والفقه، شرعية علم الفلك في تحديد المواقيت الشرعية" دعا بعض علماء الدين في شكل حاسم الى اعتماد علم الفلك في الحسابات لتبيان اوائل الاشهر الهجرية، في حين تمسك البعض بالرؤية البصرية للهلال، بينما تراوحت كلمات البعض بين دعوتين:
الاولى: يدعو الى عدم جواز تخطي الموقف (القاعدة الشرعية المتوارثة) المستندة الى الحديث النبوي الشريف &laqascii117o;صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته".
الموقف الثاني: يدعو الى ضرورة الملاءمة والتوفيق بين الفقه وعلم الفلك. وقد اجاد الكثير من العلماء في هذا المؤتمر عند الحديث عن علم الفلك وحساباته وعلى ضرورة فك الارتباط الظالم بينه وبين (التنجيم والشعوذة) اللذين يمارسهما بعض المتسترين بمعرفة علم الفلك لاستغلال البسطاء من الناس وزيادة معاناتهم ومآسيهم. لقد بات واضحاً ان المؤتمرين وجدوا انفسهم في مواجهة عدد من العناوين ومن اهمها اعتماد الحساب الفلكي مع امكانية الرؤية، آملين القاء الضوء عليها الى جانب الاراء الاخرى.
ان المتتبع للتطور العلمي يؤكد على وجود دقة في الحسابات الفلكية التي لا تدخل في اطار الظنون سواء فيها ما يتعلق بولادة الهلال او دراسة حالة الضوء.
امام هذه المشكلة نطرح السؤال بالشكل التالي:
هل بالامكان الوصول الى تقويم هجري عالمي اساسه المدار المنتظم للقمر حول الارض وشبيه الى حد بعيد بالتقاويم الشمسية المنتظمة التي يتم استخدامها في معظم بلدان العالم غير الاسلامية التي تنظم اعيادها الدينية على اساس التقويم الشمسي؟ انها تدخلنا في مشكلة الاهلة التي يعيشها المسلمون مرتين كل عام بسبب الخلاف على اثبات الاشهر الشرعية.
ولقد اشار الدكتور خالد الزعاق خلال المؤتمر أن &laqascii117o;الطريقة المتبعة لاثبات هلال اشهر (رمضان) و(شوال) و(ذي الحجة) تعتمد على اثبات رؤية الاهلة ولو كانت مخالفة لرؤية المراصد العلمية والحسابات الفلكية. وهذه الطريقة تظهرنا امام العالم في مظهر لا علمي، لذلك نحن في حاجة ماسة لتدخل العلم الحديث لحل هذه المشكلة". أما (الدكتور مسلم شلتوت) من المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر فأكد دقة الحسابات الفلكية في اثبات الاشهر الهجرية وايد كل دعوة لاستخدام الحسابات الفلكية كمدخل للرؤية الشرعية الصحيحة من دون ان يشكل بديلا عنها. اما (السيد جعفر فضل الله) فدعا علماء الفلك الى المساهمة في تعزيز حضور هذا العلم بين العلماء والناس ليتعرف الجميع على مدى الدقة التي بات يتمتع بها البحث العلمي الفلكي ونتائجه. نخلص من هذه الافكار لنتتبع ما قاله مفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار: &laqascii117o;التماس الهلال ليس غاية عبادية في حد ذاته ولكن هو وسيلة واجبة للوصول الى غاية عبادية صحيحة. لذلك لا مانع من استعمال كل الوسائل المتاحة لاثباته، ولكن ذلك لا يعني التسليم، بان الحساب الفلكي يخلو من اضطراب في البناء عليه والاكتفاء به وحده دون اعمال الرؤية.." الى متى سيبقى كثير من العلماء والفقهاء في موقف المتحفظ من استعمال الحساب الفلكي وهل من الجائز ان نقف كل عام مع بداية شهر الصوم لنسأل متى سيبدأ الاول من رمضان؟ فيكون الجواب غدا عند البعض وبعد غد عند البعض الاخر.
اليس من المعيب ان لا يكون عيد الفطر في يوم واحد اقله في الدول الاسلامية المجاورة بعضها لبعض؟
اذا بقينا على هذا المنوال متمسكين بالرؤية الشرعية دون غيرها من الوسائل العلمية المتاحة التي اثبت العلم دقة نتائجها فسيبقى العيد عيدين والرؤية رؤيتين. ان الوصول الى تحديد مواعيد الاهلة الشرعية يتطلب دعوة الى اطلاق حرية البحث والاجتهاد واستمرار الجهود والمؤتمرات لتشكل ضغطا علميا وفقهيا من اجل الوصول الى حل الخلاف على تحديد الاشهر الهجرية في طريقة شرعية علمية ما يساعد في توحيد المسلمين واعيادهم.
ـ صحيفة 'اللواء'
صلاح سلام:
أكثر ما يخشاه أهل العقل والحكمة هذه الأيام، أن يكون الشعور بـ<فائض القوة> المهيمن على مواقف بعض الأطراف السياسية في فريق 8 آذار السابق، فضلاً عن عوامل محلية واقليمية أخرى، وراء مثل هذه الاندفاعة المحمومة، التي لا تقف فقط عند حدود الضغط على رئيس الحكومة لفتح ملف شهود الزور وضرب مصداقية المحكمة قبل أن تبدأ عملها، بل قد يكون وراء الأكمة ما وراءها، عندما تظهر الأهداف الحقيقية لمثل هذه الإندفاعة الهادفة الى تحقيق انقلاب سياسي متعدد المرامي والأهداف، قد يبدأ بإسقاط الحكومة الحالية ومنع عودة الحريري الى السراي الكبير على رأس الحكومة العتيدة، وصولاً الى إلغاء التزامات لبنان مع المحكمة الدولية على الصعيدين القضائي والمالي&bascii117ll;
وثمّة ما يشير الى أن الهدف الأكبر لأصحاب هذا <الانقلاب السياسي>، إذا تحقق، هو العمل على جراحات متعددة لاتفاق الطائف، بهدف إدخال تعديلات جذرية عليه، تُطيح التوازنات الدقيقة التي أنهت خمسة عشر عاماً من الحروب العبثية، الأمر الذي يهدد بإعادة البلاد الى أجواء الحروب الانتحارية التي لن تقف هذه المرة قبل تحقيق الحلم الصهيوني بضرب الصيغة اللبنانية، وإثبات فشل تعايش الديانات المختلفة في نظام واحد، مما يعزز المطالبة الصهيونية المزمنة باعتبار <اسرائيل دولة يهودية>، من جهة، فضلاً عن أن إعادة لبنان الى مرحلة الحروب العبثية يعني التخلص من خطر المقاومة الاسلامية الحالية، التي سترتد الى الداخل وتنشغل بحروب الطوائف والمذاهب، التي ستقود الوطن الصغير الى مهاوي التقسيم، على نحو ما هو مخطط له لكل من السودان والعراق واليمن&bascii117ll;
فهل ثمّة بين اللبنانيين، مهما بلغ شعوره بالقوّة الفائضة، من يخاطر بمصير جمهوره أولاً، وبمستقبل الوطن ثانياً وثالثاً ورابعاً&bascii117ll;&bascii117ll;
ويركب متن مثل هذه المغامرة الهوجاء تحت تأثير إيحاءات داخلية وإقليمية تجعل من الشعب اللبناني وقوداً لمخططاتها في المنطقة؟
ـ صحيفة 'المستقبل'
الحكم بالتوافق.. والأمن بالتراضي!
محمد السماك:
أمران شاذان أصبحا من تقاليد السياسة اللبنانية.
الأمر الأول هو الاحتكام الى السلاح لدى وقوع أي خلاف في المواقف أو حتى مجرد اختلاف في وجهات النظر. وغالباً ما يؤدي هذا الأمر الى سقوط ضحايا بين قتلى وجرحى. كما يؤدي الى حرائق وخراب ودمار في الممتلكات الخاصة والعامة. ولأن السلاح موجود سراً وعلانية وبكميات كبيرة وبأنواع مختلفة مع معظم الأفرقاء ولو بنسب متفاوتة فإن الاحتكام اليه يجري على أساس الاعتقاد بأنه أقصر الطرق الى بلوغ الهدف.
أما الأمر الثاني فهو تحول دور قوى الأمن من حافظ للأمن العام وفارض لهيبة القانون، الى دور المصلح بين ذات البين. فلدى وقوع أي صدام مسلح بين أي فريقين، كما حدث في الأسبوع الماضي في بيروت بين حزب الله وجمعية المشاريع (الأحباش)، فإن قوى الأمن لا تتدخل إلا بعد اتصالات مع الطرفين المتقاتلين وبعد موافقتهما. ويقتصر دور هذه القوى على جمع المسؤولين من الطرفين للاتفاق على وقف النار وسحب المسلحين من الشوارع وإصدار بيان مشترك باستنكار ما حدث واعتباره حادثاً فردياً لن يعكر صفو العلاقات الأخوية بينهما. وبذلك يعود كل طرف مع سلاحه الى موقعه وكأنه عائد من مناورة بالذخيرة الحية. فيما يتولى ذوو الضحايا دفن أحبائهم أو السهر على معالجتهم في المستشفيات.. وإعادة ترميم بيوتهم المدمرة، وأثاثهم المحترق عن طريق الاستعانة بقروض مصرفية وبفوائد مرتفعة.
يشكل هذان الأمران ظاهرة سياسية أمنية لا تعرف مثيلاً لها أي دولة عربية أخرى. وهذه الظاهرة ليست جديدة على الحياة السياسية الأمنية اللبنانية فقد عرفها لبنان طوال سنوات الحرب الداخلية التي عصفت به من عام 1975 حتى عام 1990. وكانت الإدارة السورية تتولى جمع ممثلي الأفرقاء المتقاتلين وتقنعهم بوجوب وقف التقاتل وتشكيل قوى مشتركة تمثل المتقاتلين للإشراف على الأمن في المناطق المتنازع على زعامتها، حتى أصبح ظهور رجل الأمن اللبناني في الشارع بلباسه الرسمي يشكل خطراً على حياته.
في الأساس نص ميثاق الطائف 1989 - الذي رعته المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. ولم ينص الميثاق على بسلط سلطة القوى الحزبية المسلحة بل على تجريدها من السلاح. ومن المعروف أن لا سلطة للدولة حيث تفرض قوى حزبية مسلحة سلطتها بقوة السلاح.
وفي الأساس أيضاً نص اتفاق الدوحة 2008 الذي رعته قطر على عدم اللجوء الى السلاح في الصراعات والخلافات المحلية.
وفي الأساس كذلك نص البيان الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية القائمة اليوم على معادلة الجيش والمقاومة والشعب للوقوف في وجه أي عدوان إسرائيلي.
غير أن ما حدث في بيروت للمرة الثالثة منذ عام 2008 يتناقض مع هذه النصوص الثلاثة. فالدولة لم تبسط سيادتها على المناطق التي تحتفظ فيها قوى حزبية بسلاحها إلا شكلاً. وبالتالي فإن قرار عدم استخدام السلاح في الخلافات السياسية المحلية بقي حبراً على ورق. فالتهديد باستخدام السلاح، واستخدامه الفعلي، لا يزال أداة من أدوات العمل السياسي، وذلك على قاعدة أن من لم يقتنع بمنطق الفريق المسلح لا بد أن يقتنع بقوة سلاحه.
ومع استفحال النتائج المترتبة على هذا الأمر لم تجد القوى الأمنية التابعة للدولة والتي تحرص على أن تتجنب الاحتكاك بالقوى الحزبية المسلحة، أي مجال للعمل سوى إصلاح ذات البين وحث المتقاتلين على 'تبويس اللحى' وعفا الله عما مضى!!.
كانت قوى الأمن تتدخل بقوة لفضّ الاشتباك. وكانت تبادر بقوة الى اعتقال المتقاتلين والى مصادرة أسلحتهم. وكانت تجلبهم الى النيابة العامة العسكرية التي تحقق معهم وتحاكمهم وتحكم عليهم. وتنفذ بحقهم الأحكام.
كان ذلك أيام زمان. عندما كان الأمن أداة لفرض هيبة الدولة ولتنفيذ القوانين والأنظمة. غير أن التخوف من أن يفسر التعرض للسلاح المنتشر بين قوى حزبية على أنه يستهدف سلاح المقاومة أصبح الأمن يتحقق بالتراضي. والتراضي حالة موقتة. وهي حالة يتوقف استمرارها أو عدمه على حسابات القوى المسلحة وحتى على أمزجتها. وقد أدى هذا الأمر الى بروز حالة الانكفاء التي تجعل من دور قوى الأمن الرسمية أشبه ما يكون بدور المشايخ المتصوفة.
فالاشتباك المسلح الأخير الذي عانت منه أحياء في بيروت، وقع بين فريقين يطرح امتلاكهما للسلاح في قلب العاصمة علامات استفهام كبيرة. بالنسبة لحزب الله وهو رأس الحربة في مقاومة العدو الإسرائيلي، لا تقع بيروت على الحدود مع العدو وبالتالي فإن السلاح في شوارعها لا يمكن أن يفسر على أنه يستجيب لحاجة المقاومة. وبالنسبة لجمعية المشاريع الإسلامية، فإنها تعلن عن نفسها بأنها جمعية إسلامية خيرية، الأمر الذي يتطلب تفسيراً لمبدأ امتلاكها السلاح.
إذا اصطدمت قوات الأمن بالفرقاء المتقاتلين أو بأي فريق منهم، فأنها تخشى أن ينعكس ذلك سلباً على وحدتها. وتعود هذه الخشية الى أن المشكلة الجوهرية التي يعاني منها لبنان هي أن الولاء الطائفي لا يزال أقوى من الولاء الوطني أو أنه في أحسن الظروف المدخل الى الولاء الوطني. وبما أن الفرقاء المسلحين ينتمون الى أديان والى مذاهب مختلفة، فإنهم يفسرون مواقفهم التي يدافعون عنها بالسلاح على أنها تعبّر عن إرادة الطائفة التي يمثلون أو التي يدّعون تمثيلها. وبما أنهم يعتبرون أن ما هو خير للطائفة هو بالضرورة خير للوطن، فإنهم يعتبرون بالتالي هذه المواقف تعبيراً عن إرادة الوطن ودفاعاً عن مصلحته العليا.
من هنا تخشى القوات الأمنية الرسمية اذا تدخلت بالقوة أن يتحول صدامها مع القوى الحزبية المسلحة الى فتنة داخلية. كما تخشى أن تعرّض هذه الفتنة وحدتها للخطر. ولقد عرف لبنان هذه المظاهر السلبية طوال سنوات المحنة الطويلة التي مر بها.. لذلك تجد القوات الأمنية نفسها مخيرة بين أمرين أحلاهما مر. إما أن تتدخل وتتعرض بالتالي لهذه المخاطر.. وإما أن تنكفئ وتكتفي بممارسة دورها التوفيقي بين القوى المسلحة في كل مرة تتعرض فيها العلاقات بين هذه القوى الى الاضطراب أو الى سوء الفهم، أو لدى وقوع 'حادث فردي' على النحو الذي عرفته بيروت أخيراً.
من هنا ولد شعار 'بيروت منزوعة السلاح'. والسلاح المطلوب نزعه هو سلاح القوى الحزبية، وليس سلاح المقاومة الذي يرتفع في وجه إسرائيل. ولكن دون نزعه أهوال سياسية وأمنية. فالسلاح الحزبي لم ينزع في لبنان إلا بالتراضي وبالتوافق. حدث ذلك بعد أن وضعت الحرب الأهلية أوزارها في عام 1990. فجمع السلاح من القوى المتقاتلة. ولم ينتزع منها. أي أنه جُمع بالتراضي ولم يُنزع عنوة. بعض هذه القوى باع ترسانته من الأسلحة الى قوى أخرى خارج لبنان. ولقد وجد هذا السلاح من يستخدمه في البلقان وفي افريقيا.
وأعيد بعضه الى مصادره إما الى سورية أو الى الجيش اللبناني. إلا أن تجديد التسلح عملية ميسرة إذا ما توفر التمويل.. والتمويل ليس مشكلة إذا كان للممول مصلحة أو مشروع سياسي.
فأثناء الحرب اللبنانية كانت القوة الشرائية للعملة اللبنانية (الليرة) مرتفعة. وكان الدولار يساوي أقل من ثلاث ليرات. ولكن عندما بدأ التمويل الخارجي للحرب يتراجع، بدأت قيمة الليرة اللبنانية بالتراجع أيضاً حتى وصلت عندما توقف التمويل الخارجي الى ثلاثة آلاف ليرة للدولار.
وهذا يعني أنه عملياً يتعذر نزع السلاح. وأنه يتعذر قطع الطريق أمام تمويل التسلح.. ولذلك يبقى قدَر لبنان هو ممارسة الحكم بالتوافق بين السياسيين.. وتوفير الأمن بالتراضي بين المسلحين.. حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً!!.